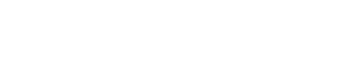(٧٠٧) مشروعية التقليد في زمن الغيبة الكبرى - إجابات علمية لشبهات المنكرين
(٧٠٧) مشروعية التقليد في زمن الغيبة الكبرى - إجابات علمية لشبهات المنكرين
مشروعية التقليد في زمن الغيبة الكبرى(1)
إجابات علمية لشبهات المنكرين
الشيخ جاسم الوائلي
لقد تداول بين المؤمنين (أعزَّهم الله) منذ مدَّة عدد من المنشورات مشتملةً على نصوص زعم ناقلها أنَّها تدلُّ على حرمة الاجتهاد والتقليد.
وكانت تلك النصوص ما بين رواياتٍ عن أهل البيت (عليهم السلام)، وكلماتٍ لبعض أعلام الطائفة الحقَّة.
ويمكن تصنيف تلك النصوص إلى خمسة أصناف:
1 - ما دلَّ على حرمة العمل بالاجتهاد، والرأي، والقياس، والاستحسان.
2 - ما دلَّ على حرمة التقليد.
3 - ما دلَّ على أنَّ الفقيه إذا أخطأ فقد كفر، وحَكَم بحكم الجاهليَّة.
4 - ما دلَّ على أنَّ الفقهاء ومقلِّديهم أعداء للدِّين وللإمام القائم (عجّل الله فرجه).
5 - ما دلَّ على حرمة العمل بالظنِّ.
وفيما يلي نستعرض النصوص بحسب هذا التصنيف، مع بيان كيفيَّة الاستدلال بها على مُدَّعاهم، ثمّ نجيب عليها تفصيلاً، ومن الله التوفيق.
الصنف الأوَّل: ما دلَّ على حرمة العمل بالاجتهاد، والرَّأي، والقياس، والاستحسان:
احتجَّ منكرو التقليد على حرمة المذكورات بروايات عن الأئمَّة (عليهم السلام)، وبكلمات بعض أعلام الطائفة، فالكلام يقع في محطَّتين:
1 - في احتجاجهم بالرِّوايات.
2 - في احتجاجهم بكلمات بعض الأعلام.
المحطَّة الأُولى: في الاحتجاج بالروايات:
وقد احتجُّوا بعدَّة روايات:
الرواية الأُولى: ما رواه أبو بصير، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): تَرِدُ علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولا سُنَّته، فننظرُ فيها؟ قال: «لا، أَمَا إِنَّك إنْ أصبتَ لم تُؤجَر، وإنْ أخطأتَ كذبتَ على الله»(2).
فأبو بصير يسأل عن القضايا التي لا يجدون لأحكامها ذكراً في الكتاب العزيز ولا في السُّنَّة المطهَّرة وأنه هل يجوز لهم أنْ يرجعوا إلى ما يُؤدِّي إليه نظرهم في تلك القضايا، أو لا يجوز؟
والمقصود من النظر هو النظر العقلي، وهو مرادف في المعنى للرَّأي، لأنَّ المقصود من الرَّأي هي الرؤية العقليَّة، فكما أنَّ النظر البصري ترادفه الرؤية البصريَّة كذلك النظر العقلي ترادفه الرؤية العقليَّة، فتكون الرواية من الروايات الناهية عن العمل بالرَّأي.
ومنكرو التقليد يستدلُّون بهذه الرواية على حرمة تقليد الفقهاء من خلال إثبات حرمة فتاواهم، بدعوى أنَّ الفقهاء يفتون بحسب آرائهم، والإفتاء بحسب الآراء محرَّمٌ كما دلَّت عليه هذه الرِّواية، وحيث إنَّ تقليد العوامِّ للفقهاء هو عبارة عن العمل بفتاواهم المحرَّمة، فيكون تقليدهم فيها محرَّماً أيضاً، لأنَّ العمل بالمحرَّمِ محرَّمٌ، وهذا أمر بديهيٌّ.
هذا أفضل ما يمكن لهم أنْ يُقرِّبوا به الاستدلال بهذه الرواية، وما كان بنفس مضمونها بالشكل الذي يرومونه.
وجوابه: أنَّ الاحتجاج علينا بهذه الرواية وغيرها من روايات هذا الصنف لهو من أعجب العجائب، ذلك لأنَّ العمل بالرَّأي هو من معالم مذاهب المخالفين لأهل البيت (عليهم السلام)، بينما حرمة العمل به هو من معالم أتباعهم (عليهم السلام)، وحرمته ممَّا أجمع عليها فقهاء الإماميَّة في جميع العصور تبعاً لأئمَّتهم (عليهم السلام)، حتَّى باتت حرمة العمل به من ضروريَّات فقه المذهب.
والأعجب من ذلك جهلُ هؤلاء بأنَّ على رأس المجمعين على حرمته هم فقهاء الطائفة أنفسهم، فإنَّهم هم الذين نقلوا لنا تلك الروايات التي حرَّمت العمل بالرَّأي، وهم الذين نقلوا الإجماع على حرمته من لدن الصدر الأوَّل للإسلام إلى يوم الناس هذا، فكيف بعد هذا يخطر إلى ذهن عاقل أنْ يعمل الفقهاء بما أجمعوا على حرمته تبعاً لما نقلوه بأنفسهم عن أئمَّتهم (عليهم السلام)؟!
إنَّه لأمرٌ عجيب حقًّا.
ومن هنا يتَّضح لك: أنَّ المستدلِّين بهذه الرواية وشبهها على حرمة التقليد لا يخلو حالهم من أحد احتمالات ثلاثة:
فإمَّا أنْ يكونوا من جهلة الشيعة الذين لا يفقهون من الروايات شيئاً، وإلَّا كيف فاتهم أنَّ الرواية تتحدَّث عمَّا هو من مَعَالم المذهب البارزة وضروريَّاته وواضحاته، وأنَّها تنهى عمَّا هو من معالم المخالفين؟!
وإمَّا أنْ يكونوا دخلاء على المذهب لا يعرفون كثيراً من معالمه وقضاياه، وإلَّا كيف جهلوا هذا الأمر الذي هو من ضروريّاته؟!
وإمَّا أنْ يكونوا عارفين بذلك، ولكنَّهم يبتغون من وراء ذلك تشتيت أتباع أهل البيت (عليهم السلام) وتفريق جمعهم، وإضعافهم، من خلال إسقاط مرجعيَّة الفقهاء، لتكون الأُمَّة بعد ذلك لقمة سائغةً أمام الحركات المنحرفة التي لا يستطيع الوقوف بوجهها إلَّا العلماء الفقهاء، وقد انطلت هذه الخدعة على كثير من العوامِّ، لاسيّما مرضى القلوب الذين لهم مواقف مسبقة من الفقهاء عامَّةً، ومن المراجع منهم خاصَّةً، خصوصاً بعد النجاح الباهر لفتوى الدفاع المقدَّس.
والعجيب في الأمر: أنَّ الرِّواية نفسها قد فرض فيها السائل أنَّ النظر كان في مقابل الكتاب والسُّنَّة، لأنَّ من الواضح أنَّ ما لا يجدونه في الكتاب والسُّنَّة لا يمكن أنْ يكون منهما، وهذا ما لا يخفى على عاقل، وبالتالي يكون المقصود من الرِّواية: أنَّ الفقيه إذا لم يجد الحكم في الكتاب ولا في السُّنَّة لا يجوز له أنْ يحكم بحسب رأيه هو، بل يجب عليه العمل بالوظيفة الشرعيَّة التي رسمتها الشريعة له في مثل تلك الحالات.
مثاله: ما لو سُئِلَ الفقيه عن حكم التدخين مثلاً - وهو من المسائل الحادثة في زمن الغيبة - فعليه الرجوع إلى عمومات الكتاب وأخبار المعصومين (عليهم السلام) لينظر هل يوجد فيها ما يشمل التدخين، أو لا يوجد؟
فإنْ لم يجد ما يدلُّ على الحرمة رجع إلى القواعد التي رسمتها له الشريعة وأوجبت عليه العمل بها في مثل هذه الحالة، كقاعدة الحِلِّيَّة المشرَّعة لكلِّ ما يُشَكُّ في حِلِّيَّته وحرمته، كما في حديث إمامنا الصادق (عليه السلام): «كلُّ شيءٍ هو لك حلال حتَّى تعلم أنَّه حرام بعينه...»(3)، وحيث لا علم للفقيه - مهما بحث وفحص - بحرمة التدخين بعينه في الكتاب ولا في السُّنَّة فيُفتي آنذاك بجوازه بحسب قاعدة الحلّيَّة المستفادة من هذا الحديث الشريف، لا بحسب رأيه هو.
وبالتالي فليست فتوى الفقيه شيئاً جاء به من بنات أفكاره وبحسب نظره وآرائه ومشتهياته كما يُصوِّره منكرو التقليد لعوامِّ الشيعة.
مثالٌ آخر: ما لو سُئِلَ الفقيه عن شيءٍ مشتبهٍ بين الطاهر والنجس، فإنَّه يرجع إلى قاعدة الطهارة التي شرَّعها المعصوم (عليه السلام) لكلِّ ما يُشَكُّ في طهارته ونجاسته، كما في حديث آخر للصادق (عليه السلام): «كلُّ شيءٍ نظيفٌ حتَّى تعلم أنَّه قذر...»(4)، فإنَّ الفقيه حينما يُفتي بطهارة شيءٍ مشكوك الطهارة إنَّما يُفتي استناداً إلى هذه القاعدة المعصوميَّة، لا إلى رأيه ونظره هو.
وممَّا ذكرنا يتَّضح لك: أنَّ الاستدلال بهذه الرواية وشبهها هو استدلال من لا علم له بمذهب الإماميَّة الذين أجمعوا تبعاً لروايات أئمَّتهم (عليهم السلام) على حرمة العمل بالرَّأي.
كما يتَّضح لك: أنَّ استدلالهم بها هو استدلال من لا يفقه من روايات أهل البيت (عليهم السلام) شيئاً، وليس له أدنى اطِّلاع على كُتُب الاستدلال لفقهائنا أصلاً.
والنتيجة: هناك فرق كبير بين من يرجع إلى عقله الناقص وفكره القاصر وآرائه الشخصيَّة لتشريع حكم من عند نفسه - كما يصنع مخالفونا في كثير من فتاواهم المستندة إلى الرأي، أو القياس، أو الاستحسان -، وبين من يرجع إلى ما استقاه من الكتاب والسُّنَّة وسجَّله في مصنَّفاته وكُتُبه، ليستنبط به ومنه ما تضمَّنته نصوص الكتاب والسُّنَّة من أحكام شرعيَّة، فأين نهج فقهائنا الذي استقوه من الكتاب والسُّنَّة من نهج المخالفين المتَّبعين لنهج غاصبي الخلافة؟!
الرواية الثانية: ما رواه مسعدة بن صدقة، قال: وقال أبو جعفر (عليه السلام): «من أفتى الناس برأيه فقد دان الله بما لا يعلم، ومن دان الله بما لا يعلم فقد ضادَّ الله حيث أحلَّ وحرَّم فيما لا يعلم»(5).
وهذه الرواية صريحة في حرمة الإفتاء بالرَّأي، فهي كالرواية الأُولى من حيث المضمون، وكلتاهما من جملة الروايات الواردة في النهي عن طريقة المخالفين لنهج أهل البيت (عليهم السلام)، كالأحناف، والمالكيَّة، وشبههم ممَّن يعتمدون في تحديد الوظائف الشرعيَّة على قواعد وطُرُق باطلة، كالقياس، والاستحسان، وما يُسَمُّونه من بِدَعهم بسَدِّ الذرائع، والمصالح المرسَلة، واجتهاد الرَّأي، وهي طُرُق تواتَرَ عن الأئمَّة (عليهم السلام) تحريمُها، وأجمع فقهاؤنا على حرمتها تبعاً للأئمَّة (عليهم السلام)، فكيف بعد هذا يُتَّهمون بأنَّهم يعملون بالرَّأي؟! إنَّه لَلْعَجَبُ العُجَاب.
وهذا يدلُّ دلالة قاطعة على أنَّ المستدلِّين بهذه الرواية وأشباهها في تحريم تقليد فقهائنا لا يفهمون شيئاً من هذه الروايات، ولا معرفة لهم بشيءٍ من طريقة الفقهاء في عملية الاستنباط، وهم الذين أفنوا أعمارهم الشريفة وبذلوا كلَّ ما لديهم من جهد علمِيٍّ وراحةِ جسدٍ وبالٍ وتحمَّلوا المخاطرَ في ضلِّ حكومات جائرة وحُكّامٍ ظلمة يقتلون على الظنَّة، كلُّ ذلك في سبيل استخراج كنوز الكتاب الكريم، وتحصيل جواهر روايات المعصومين (عليهم السلام)، لهداية الأُمَّة على ضوء هداية الثقلين: كتاب الله، وعترة رسوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم).
وبالإجابة على الاستدلال بهذه الرواية وسابقتها على مدّعاهم تستطيع أنْ تُجيب على استدلالهم ببقيَّة الروايات الدَّالَّة على حرمة الإفتاء بالرأي بأنَّ المقصود منها هو حرمة ما جرى عليه المخالفون لنهج أهل البيت (عليهم السلام)، من العمل بمثل القياس، والرأي، والاستحسان، وغير ذلك من القواعد الباطلة.
وأمَّا فقهاء الشيعة فقد منَّ الله تعالى عليهم باثني عشر إماماً بعد النبيِّ الأكرم (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وقد استطاعت أحاديثهم (عليهم السلام) أنْ تُغطّي مختلف مناحي الحياة وموارد الابتلاء، ولم يتركوا شيعتهم بلا دليل يرجعون إليه في زمن الغيبة الصغرى، ولا الكبرى، ومن اعتقد أنَّهم (عليهم السلام) تركونا بلا دليل فقد اتَّهمهم - حاشاهم - بالتقصير في واجبهم الإلهي تجاه عباد الله، وهم الذين نصبهم الله لهداية الناس أجمعين، لاسيّما شيعتهم الموالين لهم إلى يوم القيامة، فقد بيَّنوا لفقهاء الشيعة جملة كبيرة من القواعد والأُصول ليرجعوا إليها في المسائل التي لا يجدون حكمها في الكتاب الكريم، ولا في الروايات الشريفة.
وإلى هذا المعنى يشير ما روي عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إنَّما علينا أنْ نُلقي إليكم الأُصول، وعليكم أنْ تُفرِّعوا»(6)، وما روي عن الرضا (عليه السلام): «علينا إلقاء الأُصول، وعليكم التفريع»(7)، فإنَّ وظيفة فقهائنا هي التفريع من تلك الأُصول للموارد التي لم يرد فيها نصٌّ خاصٌّ، كما مثَّلنا فيما سبق بمسألة التدخين.
الرواية الثالثة: ما نسبه منكرو التقليد في منشورهم إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) من أنَّه قال: «نحن إنَّما ننفي القول بالاجتهاد لأنَّ الحقَّ عندنا فيما قدَّمنا ذكره من الأُمور التي نصبها الله تعالى والدلائل التي أقامها لنا كالكتاب، والسُّنَّة، والإمام الحجَّة، ولن يخلو الخلق من هذه الوجوه التي ذكرناها، وما خالفها فهو باطل».
قال منكرو التقليد: ثمّ ذكر (عليه السلام) كلاماً طويلاً في الرَّدِّ على من قال بالاجتهاد(8).
هكذا نقلوا الرواية كدليل على بطلان الاجتهاد، وبالتالي بطلان تقليد العوامِّ للمجتهدين.
والجواب: أنَّ هذه الرواية هي مقطع من رواية بتروها من الطرفين لتحقيق غايتهم، كفعل إخوانهم من الوهّابيَّة ونظرائهم من النواصب.
وإنَّما يجوز تقطيع الرواية فيما إذا لم يُؤثِّر تقطيعها على معناها تأثيراً سلبيًّا، وإلَّا كان ذلك تدليساً، أو غفلةً على أحسن التقادير.
أمَّا أنَّها مبتورةٌ من الأوَّل فلأنَّ هذا المقطع هو جزء صغير من رواية طويلة جدًّا نقلها صاحب الوسائل في ستِّ صفحات تقريباً، وهذه الرواية الطويلة اقتطعها صاحب الوسائل من رواية أطول منها بكثير وكثير من رسالة (المحكم والمتشابه) للسيِّد المرتضى (قدّس سرّه)، والسيِّد نقلها بدوره من تفسير النعماني محمّد بن إبراهيم المعروف بأبي زينب تلميذ الشيخ الكليني (قدّس سرّه)، وهو بدوره نقل كلاماً عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، لكنَّه خلطه بكلامه، ولم يُميِّزه عن كلام الإمام (عليه السلام) على طريقة القدماء، كالشيخ الصدوق في بعض كُتُبه، فتوهَّم صاحب الوسائل أنَّ الكلام بطوله لأمير المؤمنين (عليه السلام)، وليس هو كذلك.
وكان الكلام في أوَّل قسم منه يتحدَّث عن بعض علوم القرآن، وفي قسم آخر عن عقائدنا في مقابل عقائد المخالفين، وفي قسم ثالث عن فقهنا في مقابل فقههم، وصاحب الوسائل نقل من القسم الثالث فقط، فيكون الكلام من أوَّله إلى آخره يتحدَّث عن طريقة أهل البيت (عليهم السلام) من تلك الجهات في مقابل طريقة المذاهب المنحرفة، ولكن المنكرين للتقليد اقتطعوا ما يُحقِّق غرضهم، فتعالوا لننظر فيما نقله صاحب الوسائل، لننظر من أين اقتطعوا ذلك المقطع.
وحيث إنَّ ما نقله صاحب الوسائل رواية طويلة فسنقتصر على النظر في أوَّلها، ثمّ وسطها، ثمَّ آخرها.
1 - أمَّا أوَّلها فقوله: «وأمَّا الرَّدُّ على من قال بالرأي والقياس والاستحسان والاجتهاد...» إلخ(9).
ومن هنا بدأ صاحب الوسائل في نقل الحديث، وهو مبدوء بواو العطف، لأنَّه معطوف على كلام قبله ممَّا نقله النعماني في تفسيره، ولم ينقله صاحب الوسائل، لعدم حاجته إليه في المعنى الذي أورد الرواية لأجله.
وها أنت ترى أنَّ الاجتهاد الوارد هنا مقرونٌ إلى بعض طُرُق المخالفين في تعيين الوظائف الشرعيَّة عندهم، وهي الرأي، والقياس، والاستحسان، ما يعني أنَّ الاجتهاد المقصود في هذا الكلام هو الاجتهاد الذي عند المخالفين، والذي يختلف عن الاجتهاد بالمعنى الذي عندنا اختلافاً جوهريًّا، وإنَّما نهت روايات أهل البيت (عليهم السلام) عن طُرُق المخالفين لأنَّهم لمَّا انحرفوا عن ورثة الكتاب والسُّنَّة أعوزتهم الأدلَّة على كثير من الأحكام الشَّرعيَّة، فلجأوا إلى تلك الطُّرُق الباطلة، والتي منها الاجتهاد بالمعنى الذي عندهم، ومنه ما نُسمِّيه بالاجتهاد في مقابل النصِّ، ومنه ما يُسمَّى باجتهاد الرَّأي، وكلاهما منهيٌّ عنه في رواياتنا، وأجمع فقهاؤنا على بطلانهما تبعاً لأئمَّتنا (عليهم السلام).
وأمَّا الاجتهاد بالمعنى الذي عندنا نحن الإماميَّة فهو عبارة عن بذل الفقيه لجهده من أجل الوصول إلى حكم الله تعالى من الكتاب، وروايات العترة الطاهرة، لا بالرأي، أو القياس، أو الاستحسان، أو غيرها من القواعد الباطلة.
2 - وأمَّا وسطها فقوله: «وأمَّا الرَّدُّ على من قال بالاجتهاد فإنَّهم يزعمون أنَّ كلَّ مجتهد مصيبٌ...» إلخ(10).
وهذا أيضاً مختصٌّ بالمخالفين لأهل البيت (عليهم السلام)، لأنَّ من المعلوم حتَّى للنواصب أنَّ الإماميَّة لا يقولون بأنَّ كلَّ مجتهد مصيب، بل يقولون: إنَّ الفقيه عليه أنْ يبذل قصارى جهده في سبيل تحصيل الحكم الشرعيِّ من الكتاب العزيز، وروايات المعصومين (عليهم السلام)، فإنْ أصاب فبها، وإنْ أخطأ كان معذوراً، ولذلك فهم يُصرِّحون بأنَّ المجتهد يُخطئ ويُصيب، ولا يقولون بأنَّ المجتهد مصيب على كلِّ حالٍ، ولذا سُمِّيَ الإماميَّةُ بالمُخَطِّئة، في مقابل من ذكرتهم الرواية، والذين يُسمَّونَ بالمصوِّبة، وهم غير الإماميَّة.
3 - وأمَّا آخرها فهو المقطع الذي دلَّسوا به على أيتام آل محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وهو قوله: «ونحن إنَّما ننفي القول بالاجتهاد لأنَّ الحقَّ عندنا فيما قدَّمنا ذكره من الأُمور التي نصبها الله تعالى والدلائل التي أقامها لنا، كالكتاب، والسُّنَّة، والإمام الحجَّة، ولن يخلو الخلق من هذه الوجوه التي ذكرناها، وما خالفها فهو باطل»(11).
وهذا صريح فيما ذكرنا من أنَّ المقصود من الاجتهاد في هذه الرواية هو المعمول به عند المخالفين الذين يعملون بمثل الرأي، والقياس، والاستحسان، في مقابل العمل بالكتاب، وروايات المعصومين (عليهم السلام)، بدليل قوله: «لأنَّ الحقَّ عندنا فيما قدَّمنا ذكره من الأُمور»، يعني: أنَّ الحقَّ منحصر فيما قدَّم ذكره من الأُمور، وهي الكتاب، والسُّنَّة، والإمام الحجَّة، وليس الحقُّ في الرَّأي وأشباهه، ثمَّ وصف تلك الأُمور التي هي المرجع لأخذ الأحكام بقوله: «التي نصبها الله تعالى، والدلائل التي أقامها لنا»، ثمَّ بيَّنها بقوله: «كالكتاب، والسُّنَّة، والإمام الحجَّة»، وهذه الثلاثة هي التي يرجع إليها فقهاء الإماميَّة، في مقابل ما يرجع إليه المخالفون من القياس، وشبهه.
والفقيه إذا بذل قصارى جهده في البحث عن الأحكام في الآيات والرِّوايات فسيجد أنَّهما تُغطِّيان جميع مناحي الحياة، وإلى هذا أشار قوله: «ولن يَخلُوَ الخلقُ من هذه الوجوه التي ذكرناها»، يعني: الكتاب، والسُّنَّة، والإمام الحجَّة (عجّل الله فرجه)، فلا يجوز الرجوع إلى غيرها، كالرأي، أو القياس، أو الاستحسان، أو غيرها من طُرُق المخالفين التي منها الاجتهاد بالمعنى الذي عندهم.
هذا مضافاً إلى أنَّ قوله: «والإمام الحجَّة» يُقصَد به أئمَّة أهل البيت (عليهم السلام)، وهم حجَّةٌ على المسلمين عامَّةً، وعلى الشيعة خاصَّةً، وهذا يدلُّ على أنَّ هذا الكلام لابن أبي زينب النعماني ݥ، وليس لأمير المؤمنين (عليه السلام)، لأنَّ عنوان الإمام الحجَّة ينطبق عليه، وبالتالي يكون (عليه السلام) من الدلائل التي أقامها الله تعالى لنا.
والمنكرون للتقليد اقتصروا على المقطع الأخير وبتروه عمَّا قبله وعمَّا بعده، لكي يُوهموا المتلقِّي أنَّه ينهى عن الاجتهاد حتَّى بالمعنى الذي هو عند الإماميَّة (أعزَّهم الله تعالى)، ولأجل التمويه على البتر من أوَّل الرواية حذفوا واو العطف من قوله: «ونحن»، وجعلوا بداية المنقول هكذا: «نحن» بلا واو، لكي لا يلتفت أيتام آل محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) الذين لا خبرة لهم في مجال دراية الحديث إلى البتر المذكور.
وأمَّا بترها من آخرها فقد وقفوا عند عبارة: (ثمّ ذكر (عليه السلام) كلاماً طويلاً في الرَّدِّ على من قال بالاجتهاد).
ولو رجعنا إلى الوسائل لوجدنا العبارة كالتالي: (ثمّ ذكر (عليه السلام) كلاماً طويلاً في الرَّدِّ على من قال بالاجتهاد في القبلة، وحاصله الرجوع فيها إلى العلامات الشرعيَّة).
وها أنت ترى أنَّ المستدلَّ وقف عند عبارة (بالاجتهاد) لكي يوهم العوامَّ بأنَّ الإمام (عليه السلام) كان يتحدَّث عن الاجتهاد بالمعنى الذي عندنا، مع أنَّ الكلام في هذه العبارة عن الاجتهاد في مسألة القبلة، وترك العلامات التي نصبها المشرِّع ليرجع إليها المسلمون في تحديد جهتها، لكنَّ منكري التقليد أرادوا - كما يصنع الوهّابيَّة - أنْ يجعلوا العبارة الأخيرة من النصوص التي تنهى عن العمل بالاجتهاد، فحذفوا عبارة: (في القبلة) وما بعدها، لكي تبدو للناظر أنَّها نصٌّ في النهي عن الاجتهاد بجميع معانيه، حتَّى بالمعنى الذي عند الإماميَّة.
ولو قالوا: إذا ثبت النهي عن الاجتهاد في مسألة تحديد القبلة فيثبت النهي عنه في جميع المسائل الفقهيَّة.
فجوابه من وجهين:
1 - أنَّ هذا من أوضح مصاديق القياس التي نهت عنه الروايات، فإنَّ النهي عن الاجتهاد في مسألةٍ لا يستلزم النهي عنه في كلِّ المسائل، لاحتمال وجود سبب مانعٍ من الرجوع إلى الاجتهاد في تلك المسألة كما سيتَّضح من الوجه الثاني.
2 - أنَّ النهي عن الاجتهاد في القبلة مختصٌّ بحالة وجود العلامات التي نصبتها الشريعة لمعرفة جهتها، كالنجم الشمالي المسمَّى بالجدي الوارد ذكره كعلامة في رواية محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن القبلة، فقال: «ضع الجدي في قفاك وصلِّ»(12).
ومحمّد بن مسلم من أهل العراق، فتكون العلامة المذكورة علامةً لأهل العراق، أو لا أقلَّ تكون علامة لأهل الكوفة التي منها محمّد بن مسلم.
وأمَّا لو فقد المكلَّف جميع العلامات لسبب أو آخر - كما لو تاه في صحراء في ليلٍ غائم لا يعرف فيه شمالاً من جنوب وشرقاً من غرب - فقد وردت روايات أُخرى عنهم (عليهم السلام) صريحة في جواز الاجتهاد في القبلة، بل في وجوبه.
منها: رواية سماعة، قال: سألته - يعني الإمام الصادق (عليه السلام) - عن الصلاة باللَّيل والنهار إذا لم يرَ الشمس، ولا القمر، ولا النجوم، قال: «اجتهد رأيكَ، وتعمَّد القبلةَ جُهدَكَ»(13).
ومنها: رواية سليمان بن خالد، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون في قفرٍ من الأرض في يوم غيمٍ، فيُصلِّي لغير القبلة، ثمَّ يصحى فيعلم أنَّه صلَّى لغير القبلة، كيف يصنع؟ قال: «إنْ كان في وقتٍ فليُعِد صلاته، وإنْ كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده»(14)، يعني: يُجزيه اجتهاده في معرفة جهة القبلة حتَّى لو تبيَّن أنَّه كان مخطئاً في اجتهاده.
وغير ذلك من الرِّوايات الدَّالَّة على جواز الاجتهاد في تحديد القبلة في صورة فقد علاماتها الشرعيَّة، بل وتدلُّ على إجزاء اجتهاده حتَّى لو تبيَّن خطؤه.
والنتيجة من كلِّ هذا: أنَّ منكري التقليد ارتكبوا التدليس مرَّتين؛ مرَّة في بتر الكلام من أوَّله، ومرَّة في بتره من آخره، وهدفهم من ذلك أنْ يبدو الكلام وكأنَّه وارد في النهي عن الاجتهاد بجميع معانيه حتَّى بالمعنى الذي هو عند الإماميَّة، وهو بذل الجهد لأجل استنباط الحكم الفقهي من مصادره الشرعيَّة، أعني: الكتاب، وروايات المعصومين (عليهم السلام).
المقطع المذكور ليس من كلام الإمام علي (عليه السلام):
هذا كلُّه لو ثبت أنَّ المقطع المذكور للإمام عليّ (عليه السلام) بالفعل، وليس من كلام النعماني ݥ، أو السيِّد المرتضى ݥ، كما توهَّم صاحب الوسائل (قدّس سرّه)، لكنَّه ليس كذلك.
والوجه في ذلك: أنَّ المقطع المذكور متطابق تمام التطابق مع لغة العلماء، ولا يخفى على أهل الحديث الفرق بين لغتهم ولغة المعصومين (عليهم السلام)، وإنَّما يحصل الاشتباه حينما يخلط الرَّاوي كلاماً قليلاً منه مع كلام المعصوم (عليه السلام)، كما حصل ذلك مع الصدوق (قدّس سرّه) في مواضع من كتاب (من لا يحضره الفقيه).
وتحقيق هذا الأمر يحتاج إلى تخصُّصٍ من جهةٍ، وكلامٍ طويل من جهة أُخرى، وكلٌّ منهما يحتاج إلى بحثٍ مستقلٍّ لا يتناسب مع بحثنا هذا.
ولكن لو تنزَّلنا وفرضنا أنَّه من كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) فقد عرفت الجواب، وأنَّ الكلام في هذا المقطع كان بصدد النهي عن الاجتهاد بالمعنى الذي عند المخالفين، لا عن مطلق الاجتهاد.
وإنْ شئتَ قلتَ: إنَّ الاجتهاد في المسائل الشرعيَّة على ثلاثة أنواع:
النوع الأوَّل: الاجتهاد في مقابل النصِّ، كاجتهادات عمر بن الخطَّاب العديدة في مقابل نصِّ الكتاب أو السُّنَّة، كما في تحريمه لمتعة النساء، ومتعة الحجِّ.
النوع الثاني: الاجتهاد في الرَّأي، بمعنى أنْ يرجع الفقيه إلى رأيه الشخصيِّ في تحديد الوظيفة الشرعيَّة، من دون استنادٍ إلى مصادر التشريع الإسلامي، كما مرَّ عليك في بعض الروايات المتقدِّمة.
النوع الثالث: الاجتهاد في الوصول إلى مراد الشريعة من خلال قواعد وضوابط ثبتت صحَّتها بالدليل، ليستعين بها الفقيه في عمليَّة استنباط الحكم من مصادر التشريع الإسلامي، أعني الكتاب العزيز، وروايات المعصومين (عليهم السلام)، والإجماع، والقطع العقلي.
والاجتهاد المنهي عنه في روايتنا ما كان من قبيل الأوَّل والثاني، دون الثالث، لأنَّه من دون الاجتهاد بالمعنى الثالث لا يمكن لأحد أنْ يستخرج الأحكام الشرعيَّة من مصادر التشريع.
بل حتَّى المنكرون لمشروعيَّة الاجتهاد - أعني بعض الأخباريِّين - هم يمارسون الاجتهاد بالمعنى الثالث على مستوى العمل رغم إنكارهم له على مستوى القول، نظير موقف المخالفين لنا في مشروعيَّة التقيَّة حينما يُنكِرونها ويُحرِّمونها على مستوى القول، ولكنَّهم يمارسونها مع الظلمة من حُكَّام المسلمين على مستوى العمل، ولا يوجد أخباريٌّ واحد إلَّا وهو يعمل بمثل (قاعدة الطهارة) و(قاعدة التجاوز) و(قاعدة الفراغ) و(قاعدة اليد) و(قاعدة سوق المسلمين) وغيرها من القواعد الفقهيَّة التي يستدلُّ بها الفقيه في تحديد الوظيفة الشرعيَّة لنفسه ولمقلِّديه.
وما من أخباريٍّ إلَّا وهو يراعي ما يقتضيه مثل قانون (الإطلاق والتقييد) و(العموم والخصوص) و(الناسخ والمنسوخ) و(المجمل والمبيَّن) و(حجّيَّة ظواهر السُّنَّة) و(حجّيَّة خبر الثقة) و(حجّيَّة الإجماع الكاشف عن حكم المعصوم (عليه السلام))، وجريان الأُصول التي شرَّعه(عليهم السلام) للمكلَّفين في حالات الشكِّ، من قبيل (أصالة الاستصحاب) و(أصالة البراءة) و(أصالة الاحتياط)، وغير ذلك من القواعد اللفظيَّة، أو الأُصوليَّة التي تتوقَّف عليها عملية الاستنباط في جميع مسائل الفقه الاجتهاديَّة.
وليس الاجتهاد إلَّا عبارة عن استعانة الفقهاء بهذه القواعد وشبهها في مجال تحديد الوظائف الشرعيَّة لأنفسهم ولمقلِّديهم، وذلك بعد أنْ أثبتوا في مرحلة سابقة وفي عدِّة علوم - كعلم الكلام، وعلم أُصول الفقه - شرعيَّة تلك القواعد، بل وأثبتوا عدم جواز نسبة أيِّ حكم - حتَّى مثل استحباب تقليم الأظفار - إلى الله تعالى، أو إلى رسوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، أو إلى واحد من الأئمَّة (عليهم السلام) من دون مراعاةٍ لتلك القواعد والضوابط.
كما أثبتوا بالأدلَّة الواضحة بطلان قواعد أُخرى وحرَّموا العمل بها تبعاً للأئمَّة (عليهم السلام)، كالقياس، والرأي، والاستحسان، والاجتهاد بالمعنيين الأوَّلين السابقين، وكقاعدتي سدِّ الذرائع، والمصالح المرسَلة، وغير ذلك من القواعد التي اعتمدها المخالفون لأهل البيت (عليهم السلام).
هذا تمام الكلام في الرواية الثالثة.
وخلاصته: أنَّها ليست رواية عن المعصومين (عليهم السلام)، وأنَّ نسبتها إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) توهُّمٌ من صاحب الوسائل، وهو معذور في ذلك، كما أنَّه لم يرتكب التدليس كما فعل منكرو التقليد عندما بتروها من أوَّلها وآخرها.
وعلى تقدير أنَّها من كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) فهي بصدد النهي عن نحوين من الاجتهاد:
1 - الاجتهاد بالمعنى الذي هو عند المخالفين لأهل البيت (عليهم السلام)، لا بالمعنى الذي عندنا نحن الإماميَّة.
2 - الاجتهاد في تحديد القبلة في حال وجود العلامات المجعولة من الشَّرع لتحديدها، دون الاجتهاد في حال فقد تلك العلامات، فإنَّه جائزٌ، بل واجبٌ.
الرواية الرابعة: ما نسبه منكرو التقليد في منشورهم إلى إمامنا الصادق (عليه السلام)، حيث جاء ما نصُّه: قال الصادق (عليه السلام) - وهو يعني الإمام المهدي (عجّل الله فرجه) بما قاله -: «أعداء الدِّين مقلِّدة الفقهاء أهل الاجتهاد ولم يرونه يحكم بخلاف ما ذهب إليه أئمَّتُهم...»، ثمَّ يواصل الكلام بعد ذلك إلى أنْ يقول: «إذا خرج فليس له عدوٌّ مبين إلَّا الفقهاء خاصَّة، وهو والسيف أخوانِ».
هكذا نقلوا في منشوراتهم التي وزَّعوها على الناس على ما فيه من تلاعب من جهة، وأخطاء من جهة أُخرى.
وقد ذكروا لهذا الحديث المزعوم مصدرين: كتاب (إلزام الناصب)، وكتاب (ينابيع المودَّة)، كما ذكروا في بعض مواقعهم المشبوهة على الإنترنت مصادر أُخرى من بينها كتاب (بشارة الإسلام).
وهذا الكلام المنسوب إلى إمامنا الصادق (عليه السلام) يشتمل على مقطعين:
أوَّلهما: «أعداء الدِّين مقلِّدة الفقهاء أهل الاجتهاد ولم يرونه يحكم بخلاف ما ذهب إليه أئمَّتُهم».
ثانيهما: «إذا خرج فليس له عدوٌّ مبين إلَّا الفقهاء خاصَّة، وهو والسيف أخوانِ».
والجواب عليه من ثلاثة وجوه:
1 - أنَّ الحديث بمقطعيه مكذوبٌ على الإمام الصادق (عليه السلام)، فإنَّ كلا المقطعين لابن عربي الصوفي المعروف ذكرهما في كتاب (الفتوحات).
أمَّا الأوَّل فقد ذكره ضمن كلامٍ له طويل جاء في أوَّله: (اعلم - أيَّدنا الله - أنَّ لله خليفة يخرج وقد امتلأت الأرض جوراً وظلماً).
إلى أنْ قال بعد كلام له طويل فيما يقوم به الإمام المهدي (عجّل الله فرجه): (يرفع المذاهب من الأرض، فلا يبقى إلَّا الدِّين الخالص).
ثمّ ذكر المقطع الأوَّل قائلاً: (أَعداؤُهُ مقلِّدَةُ العُلماءِ أَهلِ الاجتهاد، لما يرونه من الحكم بخلاف ما ذهبت إليه أئمَّتُهم).
ثمّ قال: (فيدخلون كرهاً تحت حكمه خوفاً من سيفه وسطوته ورغبةً فيما لديه، يفرح به عامَّةُ المسلمين أكثرُ من خواصِّهم، يبايعه العارفون بالله من أهل الحقائق عن شهودٍ وكشفٍ بتعريفٍ إلهي...) إلى آخر كلامه(15).
وأمَّا المقطع الثاني فقد ذكره أيضاً ضمن كلام طويل انتقد فيه فقهاء المذاهب الأُخرى، ومدح الصوفيَّة والعرفاء ممَّن كانوا على مسلكه، وقال: (وإذا خرج هذا الإمام المهدي فليس له عدوٌّ مبينٌ إلَّا الفقهاء خاصَّةً...).
إلى أنْ قال: (ولولا أنَّ السيف بيد المهدي لأفتى الفقهاء بقتله، ولكن الله يُظهِره بالسيف والكرم، فيطمعون ويخافون، فيقبلون حكمه من غير إيمانٍ، بل يضمرون خلافه كما يفعل الحنفيُّون والشَّافعيُّون فيما اختلفوا فيه...).
إلى أنْ قال في وصفهم: (فمثل هؤلاء لولا قهر الإمام المهدي بالسيف ما سمعوا له، ولا أطاعوه بظواهرهم، كما أنَّهم لا يطيعونه بقلوبهم، بل يعتقدون فيه أنَّه إذا حكم فيهم بغير مذهبهم أنَّه على ضلالةٍ في ذلك الحكم، لأنَّهم يعتقدون أنَّ زمان أهل الاجتهاد قد انقطع، وما بقي مجتهدٌ في العالم، وأنَّ الله لا يُوجِد بعد أئمَّتهم أحداً له درجة الاجتهاد...) إلى آخر كلامه(16).
والحاصل: أنَّ الكلام بمقطعيه لابن عربي، وليس لإمامنا الصادق (عليه السلام).
2 - قد اتَّضح لك من كلامه الأخير الذي لم ينقله منكرو التقليد للتدليس على المؤمنين أنَّ المقصود بالمقلِّدين لأهل الاجتهاد هم عوامُّ أهل السُّنَّة المقلِّدون لأحد الأربعة: (مالك، وأبي حنيفة، والشَّافعي، وابن حنبل) الذين هم أهل الاجتهاد الذين يعتقد مقلِّدوهم بأنَّ الاجتهاد قد خُتِمَ بهم، وأنَّ الله تعالى لن يخلق مجتهداً بعدهم.
3 - أنَّ من المقطوع به والبديهي أنَّ الأحكام التي يأتي بها الإمام المهديُّ (عجّل الله فرجه) ستكون على طبق أحكام آبائه (عليهم السلام) المودوع أكثرُها في كُتُبنا الحديثيَّة، وهي أحكامٌ مخالفة لأحكام المخالفين التي هي اجتهادات أئمَّتهم الأربعة، ولذا حينما يأتي بأحكام آبائه (عليهم السلام) سوف يعاديه أتباع تلك المذاهب، لأنَّهم يرون أنَّ أحكامه (عجّل الله فرجه) مخالفةٌ لأحكام أئمَّتهم الأربعة، كما علَّل بذلك ابن عربي في قوله: (لما يرونه من الحكم بخلاف ما ذهبت إليه أئمَّتهم).
والنتيجة: قد اتَّضح أنَّ الحديث المذكور هو من كلام ابن عربيٍّ في حقِّ المخالفين، وقد نسبه منكرو التقليد إلى إمامنا الصادق (عليه السلام) افتراءً عليه، وتدليساً على المؤمنين، فليتبوَّأ الكاذب مقعده من النار، وكذلك من علم به منهم وسكت عنه ولم يردعهم، بل ساعده في نشر هذه الأُكذوبة ﴿وَاللهُ مِنْ وَرائِهِمْ مُحِيطٌ﴾ (البروج: 20).
الرواية الخامسة: ما نقله منكرو التقليد في منشوراتهم عن كتاب (إلزام الناصب) من أنه: ذكر الصادق (عليه السلام) يوماً أهل الفتوى وهو مغضب: «إذا خرج القائم ينتقم من أهل الفتوى بما لا يعلمون، فتعساً لهم ولأتباعهم».
وفي الطبعة التي عندي هكذا: «وينتقم من أهل الفتوى في الدِّين لما لا يعلمون، فتعساً لهم ولأتباعهم»(17).
وجوابه في نقاط:
1 - أنَّ هذه الرواية قطعة من خطبة البيان المنسوبة إلى الإمام عليّ (عليه السلام)، وليست من كلام الإمام الصادق (عليه السلام)، كما أنَّها خالية من فقرة: (ذكر أهل الفتوى يوماً وهو مغضب)، فيكونون قد كذبوا على الإمام الصادق (عليه السلام) في هذه الرواية أيضاً، كما كذبوا عليه في الرواية السابقة، ومن يكذب على الإمام متعمِّداً مرَّةً يمكن أنْ يكذب عليه ألف مرَّة.
2 - أنَّ سند الخطبة ضعيفٌ جدًّا، لانحصاره بسند واحد رواته كُلُّهم من المخالفين لأهل البيت (عليهم السلام)، ولم يروها أعلامنا من أمثال الكليني، والصدوق، والمفيد، والمرتضى، والطوسي، ولا غيرهم ممَّن تأخر عنهم، كالشيخ محمّد تقي المجلسي، بل صرَّح ولده العلَّامة محمّد باقر المجلسي في كتابه (مرآة العقول) بكذبها، وكذب أمثالها، وجعلها من روايات الغُلاة وأشباههم(18)، ولذا فقد حكم بضعف سندها جملة من الأعلام المحقِّقين قديماً وحديثاً، فكيف يجوز بعد هذا كلِّه لمن يدَّعي التشيُّع أنْ ينسب إلى إمامه رواية ساقطة عن الاعتبار بالمرَّة؟!
وما الفرق بين من يكذب على المعصوم (عليه السلام) متعمِّداً وبين من يسند إليه حديثاً لم يكن سنده في غاية الضعف فحسب، بل توجد في نفس الخطبة قرائن - كما يأتي بيان بعضها - تدلُّ على عدم صدورها عنه (عليه السلام)، ولا عن واحد من أولاده (عليهم السلام).
3 - أنَّ في كثيرٍ من فقرات الخطبة ركاكة واضحة يجلُّ عن مثلها أمير البلاغة والبيان، والذي ما سَنَّ الفصاحة لقريش إلَّا هو.
4 - أنَّ كثيراً من مضامينها باطلة في مذهب أهل البيت (عليهم السلام).
ولو قال قائل: ألم يرد بعض مضامينها في رواياتنا؟
فجوابه: أنَّ بعض المنحرفين حينما يريدون أنْ يدسُّوا أُموراً باطلة في روايات المعصومين (عليهم السلام) فإنَّهم يعمدون إلى روايات صحيحة فيدسُّون فيها ما يريدون دسَّه، كما كان يصنع المغيرة بن سعيد وأبو الخطَّاب (لعنة الله عليهما)، حيث كان الأوَّل يدسُّ في أحاديث إمامنا الباقر (عليه السلام)، والثاني يدسُّ في أحاديث الإمام الصادق (عليه السلام).
ولو قال قائل: إذا كان الأمر كذلك فلماذا ينقل علماؤنا هذه الروايات عن المخالفين في كُتُبنا؟
فجوابه واضح: فإنَّ نقل أمثالها عنهم إنَّما هو من باب إلزامهم بما ينقلون، كما صنع الشيخ الحائري في كتابه (إلزام الناصب)، ليفحم بما نقلوه من أنكر منهم وجود المهدي (عجّل الله فرجه) من النواصب وغيرهم، ولذا سَمَّى كتابه (إلزام الناصب)، وهو ما نصنعه نحن اليوم حينما نحتجُّ عليهم بمثل كتاب البخاري، وكتاب مسلم، وأمثالهما، ونستدلُّ عليهم بما نقله رواتهم، كأبي هريرة، وأضرابه ممَّن عُرفوا عندنا بالكذب، وذلك من باب إلزامهم بما نقلوه في كُتُبهم.
5 - ذكر المؤلِّف أنَّ للخطبة نُسَخاً مختلفةً(19)، ونقل ثلاث نُسَخ منها، والمقطع المذكور ورد في واحدة منها فقط، ولا مثبت أنَّها هي الصادرة عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، بل يحتمل أنَّها موضوعة من قِبَل بعض الرُّواة الذين هم من المخالفين، لاسيّما وأنَّ بعضهم من الصوفيَّة الذين لا يخفى على المتابع عداؤهم للفقهاء، وهذا الإشكال يرد أيضاً على رواية ابن عربي - الرواية الرابعة المتقدِّمة -، فإنَّه كان من أشدِّ الناس عداوةً للفقهاء، ولئن قصد فقهاء مذاهبهم فلا شأن لنا بهم، لأنَّ فقهاءَنا (أُمناء الرُّسُل) و(ورثة الأنبياء) كما ورد في الأحاديث السابقة.
6 - لو غضضنا النظر عن كلِّ ما تقدَّم فقد اتَّفقت روايات أئمَّتنا (عليهم السلام) وفتاوى فقهائنا على حرمة الإفتاء بغير علم، حتَّى بات هذا الحكم من ضروريَّات الدِّين لا يختلف فيه اثنان من المسلمين، وغاية ما تدلُّ عليه هذه الرواية هو أنَّ المهدي (عجّل الله فرجه) سينتقم ممَّن يُفتون بغير علم، لا من جميع أهل الفتوى بمن فيهم الذين يفتون بعلم، لأنَّ الخطبة قيَّدت الانتقام بذلك في جملة: «بما لا يعلمون».
ولا أدري ما علاقة هذا بمراجعنا الذين بلغوا من العلم في الأحكام الشرعيَّة أعلى رتبة فيه، وهي رتبة الاجتهاد والفقاهة؟!
7 - لو لاحظنا تكملة المقطع لوجدنا فيها مقاطع تتحدَّث عن أهل الفتوى من المخالفين، كبعض الصحابة وأمثالهم من الذين خالفوا عليًّا (عليه السلام).
ومن تلك المقاطع قوله: «أكان الدِّين ناقصاً فتمَّمُوه، أم كان به عِوَجٌ فقَوَّموه...» إلى أنْ قال: «فكم من وليٍّ جحدوه، وكم وصيٍّ ضيَّعوه، وحقٍّ أنكروه، ومؤمنٍ شرَّدوه، وكم من حديثٍ باطلٍ عن الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وأهل بيته نقلوه، وكم من قبيحٍ منَّا جوَّزوه، وخبرٍ عن رأيهم تأوَّلوه...» إلى أنْ قال: «ألَا إنَّ في قائمنا أهل البيت كفاية للمستبصرين، وعبرة للمعتبرين، ومحنة للمتكبِّرين، لقوله تعالى: ﴿وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذابُ﴾ (إبراهيم: 44)، هو ظهور قائمنا المُغيَّب، لأنَّه عذابٌ على الكافرين، وشفاء ورحمة للمؤمنين...» إلخ.
فانظر أيُّها الشيعيُّ بعين فطرتك العلويَّة وعقيدتك الصادقيَّة هل تجد هذا منطبقاً على شيعة أهل البيت (عليهم السلام) وعلى رأسهم الفقهاء الذين أفنوا حياتهم في الدفاع عن النبيِّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وأهل بيته (عليهم السلام)، وحافظوا على تراثهم، ونقلوه لأتباعهم في كلِّ زمانٍ ومكانٍ، واستنبطوا مقاصدهم، وبيَّنوا للناس أحكامهم؟!
والخلاصة: أنَّ خطبة البيان ضعيفة سنداً، ومتناً، ودلالةً، فهي ساقطة عن الاعتبار جدًّا، وغاية ما تدلُّ عليه الفقرة المقتطعة منها هو حرمة الإفتاء بغير علم، وهو ممَّا اتَّفقت عليه النصوص والفتاوى من كلا الفريقين، ولم يأتِ منكرو التقليد بشيءٍ جديدٍ، ولا ربط له بحرمة تقليد مراجعنا من قريب ولا من بعيد.
الرواية السادسة: ما روي عن أبي شيبة الخراساني، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إنَّ أصحاب المقائيس طلبوا العلم بالمقائيس، فلم تزدهم المقائيس من الحقِّ إلَّا بُعداً، وإنَّ دين الله لا يُصاب بالمقائيس»(20).
إن الرِّواية تدلُّ على أنَّ الدِّين - ومنه الأحكام الشرعيَّة - لا يمكن التوصُّل إليه بالقياس، وأنَّ من طلبه بالقياس فسوف يزداد عن الحقِّ بُعداً.
وهناك روايات أُخرى دلَّت على حرمة العمل بالقياس، وسوف نكتفي بهذه الرواية، لدلالة جميع الروايات على معنى واحد، وهو النهي عن العمل بالقياس في المسائل الدِّينيَّة، ومنها الأحكام الشرعيَّة.
وقد استدلَّ منكرو التقليد بهذه الروايات على عدم مشروعيَّة تقليد فقهائنا، بزعم أنَّهم يعملون بالقياس في استنباط كثير من الأحكام الشرعيَّة، ولازمه أنَّ تقليد العوامِّ للفقهاء في تلك الأحكام محرَّمٌ وباطل.
وجوابه: أنَّ علماء المسلمين كافَّةً - بل حتَّى الخوارج والنواصب - يعلمون أنَّ من أبجديَّات مذهب الإماميَّة وضروريَّاته تحريمهم للعمل بالقياس، فكيف بعد هذا يفترون - وبكلِّ جرأةٍ - ويدَّعون أنَّ فقهاء الإماميَّة يعملون بالقياس؟!
وهذا إنْ دلَّ على شيءٍ فإنَّما يدلُّ على أنَّ الذين يقفون وراء الدعوة إلى ترك تقليد الفقهاء هم أُناس أجنبيُّون عن الإسلام والمسلمين، أو لا أقلَّ هم أجنبيُّون عن مذهب الإماميَّة، وإلَّا كيف يقع المروِّجون لهم من بسطاء الشيعة في هكذا خطأ فضيعٍ لا تقوم لهم بعده قائمة؟!
إنَّ هذه الدعوى أشبه بما لو ادُّعي أنَّ الإماميَّة الاثني عشريَّة لا يعتقدون بإمامة الصادق (عليه السلام) مثلاً.
والمضحك المبكي أنَّهم نقلوا عباراتٍ لأعلام الطائفة صريحةٍ في حرمة العمل بالقياس كما سوف يأتي إنْ شاء الله تعالى.
والحاصل: أنَّ العمل بالقياس ممَّا أجمع فقهاء الطائفة على حرمته تبعاً لأئمَّة الهدى (عليهم السلام)، فكيف بعد هذا يتَّهمونهم بالعمل به؟!
شبهة وجواب:
ربَّما قرأ بعض في كُتُبنا أو سمع أنَّ فقهاءنا يعملون ببعض أنواع القياس، فتخيَّل أنَّهم يعملون بما نهت الروايات عنه.
وجواب هذه الشبهة: أنَّ القياس يأتي على عدَّة معانٍ، والذي نهت عنه الروايات هو القياس بأحد معانيه لا بجميعها، وهي عديدة نذكر بعضها:
(فمنها): القياس المُستَنبَط العلَّة.
(ومنها): قياس الأولويَّة.
(ومنها): قياس المساواة.
(ومنها): القياس على كتاب الله تعالى.
والمنهي عنه في الرِّوايات هو الأوَّل دون البقيَّة.
توضيح ذلك:
أمَّا القياس المستنبط العلَّة فهو: أنْ يرد نصٌّ من الشرع لبيان حكمٍ في مورد معيَّنٍ، ويحاول الفقيه أنْ يستفيد منه في مورد آخر لم يرد فيه نصٌّ، وحجَّته في ذلك وجود شبهٍ بين المورد المنصوص عليه والمورد الخالي من النصِّ، ويسمُّون المنصوص عليه: (الأصل)، وغير المنصوص عليه: (الفرع)، ثمّ ينقل الفقيه الحكم من الأصل إلى الفرع لأجل الشبه الذي بينهما.
ولتقريب الفكرة نُمثِّل بمثال تعليمي لا واقعي، رعايةً لعموم القارئين، فنقول: قد نصَّ الكتاب الكريم على أنَّ عدَّة المتوفَّى زوجُها أربعةُ أشهرٍ وعشرةُ أيّامٍ، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً﴾ (البقرة: 234)، فلو أراد الفقيه التعرُّف على عدَّة المفقود زوجها مثلاً بعد أنْ يُطلِّقها الحاكم فإنْ لم يجد نصًّا لبيان عدَّتها فربَّما قاسها على المتوفَّى زوجها وأفتى بأنَّ عدَّتها عدَّة وفاةٍ، لا عدَّة طلاق، والتي هي ثلاثة قروءٍ، أو ثلاثة أشهرٍ.
واستفادة هذا الحكم من القياس ممَّا أجمع فقهاؤنا على حرمته تبعاً لما تواتر عن أئمَّتنا (عليهم السلام)، ولو جاءت به السُّنَّة كان مقبولاً، لأنَّ السُّنَّة حجَّةٌ.
ومنه يتَّضح: أنَّ اتِّهام فقهائنا بذلك لهو أقوى دليل على أنَّ المسوِّقين لهذه التهمة إمَّا أنْ يكونوا من الجهلة، وإمَّا أنْ لا يكونوا من الشيعة أصلاً.
وأمَّا قياس الأولويَّة فهو: أنْ يرد نصٌّ من الشرع لبيان حكمٍ في موردٍ معيَّنٍ، وكانت علَّة الحكم مقطوعاً بها، فإذا وجد الفقيه تلك العلَّة في موردٍ آخر وبدرجةٍ أقوى وأشدَّ فيحكم بنفس ذلك الحكم بلا إشكال.
ومن هنا سُمِّيَ بقياس الأولويَّة، لأنَّ الحكم إذا كان ثابتاً في المورد الأوَّل لعلَّةٍ معيَّنةٍ فبالأولى أنْ يثبت في مورد تكون تلك العلَّة فيه أقوى.
ومثاله التعليمي: لو لم يرد نصٌّ يُحرِّم شتم الوالدين مثلاً فيمكن للفقيه استفادة الحرمة من مثل قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ﴾ (الإسراء: 23)، الذي يدلُّ على حرمة قول كلمة: (أُفٍّ) للوالدين، والتي هي مجرَّد إبرازٍ للتضجُّر منهما، فما بالك لو شتمهما؟
ولذا يحتجُّ المستدلُّ ويقول: إذا كانت الآية تدلُّ على حرمة كلمة: (أُفٍّ) في حقِّ الوالدين فهي تدلُّ على حرمة شتمهما بالأولويَّة القطعيَّة، حتَّى لو لم يرد نصٌّ خاصٌّ في تحريم شتمهما.
ومن هذا يتَّضح لك: أنَّ قياس الأولويَّة لا يتحقَّق إلَّا بعد تحقُّق شرطين قد أشرنا إليهما:
1 - أنْ يقطع الفقيه بعلَّة الحكم في المورد المنصوص عليه، كما هو الحال في الآية الشريفة، فإنَّ كلَّ عاقل يقطع بأنَّ علَّة تحريم كلمة (أُفٍّ) هي إيذاء الوالدين، والله تعالى حرَّم إيذاءهما حتَّى بهذا المقدار القليل.
2 - أنْ يقطع الفقيه أيضاً بأنَّ هذه العلَّة الموجودة في هذه الكلمة موجودة في كلمات أُخرى مؤذية للوالدين بشكل أكبر وأشدَّ، كإطلاق الكلمات البذيئة في حقِّهما وتعييرهما بصفةٍ ما، كالفقر، أو الجهل، أو غير ذلك من الكلام الجارح لقلبيهما، فإذا قطع الفقيه من هاتين الجهتين خرج بهذه النتيجة: إذا كان يحرم على الولد أنْ يقول لوالديه: (أُفٍّ) فقطعاً وبكلِّ تأكيد يحرم عليه أنْ يقول لهما ما هو أشدُّ عليهما من هذه الكلمة، وأكثر إيذاءً لهما منها.
ومن دون تحقُّق هذين القطعين للفقيه لا يجوز له أنْ ينقل حكم المورد المنصوص عليه إلى المورد الذي لا نصَّ فيه، حتَّى لو حصل له ظنٌّ بذلك، لأنَّه سيكون آنذاك من مصاديق القياس المستنبط العلَّة المنهي عنه.
وبهذا يتَّضح الفرق بين القياس المستنبط العلَّة وقياس الأولويَّة، فالمستنبط العلَّة يعتمد على الظنِّ، وهو ممَّا لا دليل على حجِّيته، بل قام الدليل كتاباً وسُنَّةً متواترةً على بطلانه، وأمَّا قياس الأولويَّة فيعتمد على القطع واليقين الذي هو حجَّة الحُجَج.
وأمَّا قياس المساواة فهو: أنْ يرد نصٌّ من الشرع لبيان حكمٍ في مورد معيَّنٍ، ويحاول الفقيه أنْ يستفيد منه في مورد آخر لم يرد فيه نصٌّ، وحجَّته في ذلك عدم وجود أيَّة خصوصيَّة للمورد المنصوص عليه، بل يجد بينهما مساواةً تامَّة من ناحية ذلك الحكم.
ومن أمثلته: ما لو حكم الشرع بوجوب تطهير الثوب من البول مثلاً، فإنَّ العُرف المخاطَب بهذا الحكم يفهم عدم وجود أيَّة خصوصيَّة للثوب في الحكم المذكور، فيتعدَّون بالحكم إلى مثل العباءة، والسِّروال، والعمامة، والشَّال، والخِمار، والجَورَب، وما شابه ذلك ممَّا يرتديه الإنسان، ممَّا صُنِعَ من الأقمشة.
بل ويتعدَّون بالحكم المذكور إلى مثل السَّجَّادة، والستائر، والأغطية، وغيرها، حتَّى لو لم يرد نصٌّ في هذه المذكورات.
ولكن يُشتَرط في جواز العمل بهذا القياس: أنْ يقطع الفقيه بعدم وجود خصوصيَّة لمورد النصِّ، فلو احتمل وجود الخصوصيَّة لمورده لم يجز له تعدية الحكم إلى الموارد غير المنصوص عليها.
وهنا تأتي مقالة الأُصوليِّين المعروفة: (إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال)، لأنَّ شرط حجّيَّة هذا القياس حصول القطع بشمول الحكم لغير مورد النصِّ.
وهناك تعبيرات أُخرى للفقهاء عن هذا القياس صارت مصطلحات في علم الفقه، كمصطلح (تنقيح المناط) و(طرح - أو نزع - الخصوصيَّة) و(وحدة الملاك) و(الحمل على المثاليَّة)، أو غيرها.
والمقصود من الأخير: أنَّ العُرف يفهم من كلام الشرع أنَّ الثوب ذُكِرَ على سبيل المثال لا الحصر، ولأجل ذلك تراه يتعدَّى إلى العباءة، والجورب، وغيرها من المذكورات.
وأمثلته في الفقه كثيرة، كما هو الحال في موارد وجوب التيمُّم فيما إذا قيَّده الشرع بحالة فقدان الماء، فإنَّ العرف يفهم منه: أنَّ شرط الانتقال إلى وظيفة التيمُّم هو وجود مانع من استعمال الماء حتَّى لو لم يكن الماء مفقوداً، كما لو كان استعماله يضرُّ بالمكلَّف، أو يوقعه في الحرج، وقد حكمت الشريعة بارتفاع الأحكام التي تتسبَّب في ضرر المكلَّف، أو الحرج، كما في قوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): «لا ضرر ولا ضرار»(21)، وقوله تعالى: ﴿وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (الحجّ: 78).
وأمَّا القياس على كتاب الله: فهو أنْ يأتي الخبر عن المعصوم (عليه السلام) وكان رواته من الثقات لكن مضمونه مشكل، كما لو كان فيه شبهة المخالفة للكتاب الكريم، فيقع الفقيه في حيرة، فمن جهة ينبغي عليه أنْ يأخذ به لأجل صحَّة سنده، ومن جهة ينبغي له التثبُّت والتريُّث في العمل به لوجود شبهة مخالفته لكتاب الله، ولأجل هذا وأمثاله توجَّهت عدَّة أسئلةٍ إلى الأئمَّة (عليهم السلام) من أصحابهم، وأنَّه ماذا نصنع في مثل هذا الحال؟
فجاءت تعليماتهم (عليهم السلام) تنصُّ على أنَّ ما جاء مخالفاً لقول الله تعالى فلم يقولوه(22)، وفي رواية أُخرى أنَّه زخرف(23)، أي باطل، وما شابه هذا المضمون(24).
وممَّا جاء في هذا المجال هو لزوم قياس الخبر على الكتاب الكريم وأحاديث المعصومين (عليهم السلام) المقطوع بصدورها عنهم، وهو ما رواه الحسن بن جهم عن الرضا (عليه السلام) أنَّه قال: قلت للرضا (عليه السلام): تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة، قال: «ما جاءك عنَّا فقسه على كتاب الله (عزَّ وجلَّ) وأحاديثنا، فإنْ كان يشبههما فهو منَّا، وإنْ لم يشبههما فليس منّا...» إلى آخر الرواية(25).
وهذه الرواية وأمثالها يُعبَّر عنها في علم الأُصول بروايات العرض على الكتاب والسُّنَّة القطعيَّة، ومفادها: أنَّ الخبر الذي لا يشبه مضمونُهُ مضامين الكتاب العزيز والسُّنَّة القطعيَّة ليس بحجَّة، وما كان يشبههما فهو حجَّة.
ومن الآثار المهمَّة لهذه القاعدة الرَّضويَّة: أنَّ الخبر الضعيف سنداً إذا كان متطابقاً مع مضامين الكتاب والسُّنَّة القطعيَّة فلا ينبغي طرحه، لاحتمال صدوره من المعصومين (عليهم السلام) ولم يصل إلينا إلَّا من الطريق الضعيف، وقد يُستفاد منه في بعض الموارد، وفي المقابل يجب طرح الحديث المخالف في مضمونه للكتاب والسُّنَّة حتَّى لو كان سنده صحيحاً.
ومن الواضح أنَّ العمل بهذا القياس ليس محرَّماً، بل جائزٌ، بل واجبٌ.
والخلاصة: أنَّ القياس على أنواع، والمنهي عنه هو القياس المستنبط العلَّة، لأنَّه يعتمد الظنَّ، وقد نهى الشرع عن اتِّباع الظنِّ إلَّا ما خرج بالدليل، والقياس المستنبط العلَّة لم يخرج بدليل، بل تواتر عن أهل البيت (عليهم السلام) النهي عن اتِّباعه.
وأمَّا بقيَّة الأقيسة - قياس الأولويَّة، وقياس المساواة، وقياس الخبر على الكتاب والسُّنَّة القطعيَّة - فهي خارجة عن باب الظنِّ من الأساس، لأنَّها تعتمد على القطع، فهي قطوع وليست ظنوناً، ولم يرد من الشرع نهيٌ عنها، فتكون حجَّة بلا إشكال، بل الأخير منها قد ورد الأمر به كما عرفت.
ولئن سمعت بفقيه من الشيعة يعمل بالقياس فالمقصود هو القياس بأحد المعاني الجائزة، أعني الثلاثة الأخيرة.
ولو بلغهم أنَّ فقيهاً عمل بالقياس المنهي عنه حملوا عليه حملة واحدةً زيادةً في الحرص على اجتنابه، وحملاً للآخرين على تحرِّي الدِّقَّة من هذه الناحية.
ولهذا الذي ذكرناه أخيراً أفتى فقهاؤنا بجواز الانتقاص من المؤمن إذا صدرت منه مقالة باطلة يخاف على المؤمنين منها، كالانتقاص بقلَّة التدبُّر، أو بقصر النظر، أو ما شابه ذلك من العبائر التي تستلزم الانتقاص من المقول فيه، وما ذلك إلَّا للحرص على أحكام الشرع من الاستدلالات المنهيِّ عنها، من باب التزاحم بين حفظ الشرع، وحفظ حرمة ذلك المستدلِّ بها.
ثمَّ بعد هذا كلِّه يأتي الغريب عن أجواء فقهائنا ومدرستهم - إمَّا لأنَّه ليس من الفقهاء، وإمَّا لأنَّه من أتباع مذهب آخر - فينسب إليهم العمل بالقياس الباطل، فإنْ لم يكن ملتفتاً إلى ما ذكرناه فهو جاهل، وإنْ كان ملتفتاً فهو كاذب ومدلِّس يريد تضليل عوامِّ الشيعة وفصلهم عن مراجعهم، كما يسعى لذلك أكثر من طرف في هذه الأيَّام، لاسيّما بعد هزيمة (داعش) بفضل فتوى المرجعيَّة بوجوب الدفاع الكفائي، وإفشالها لمُخطَّطات الأعداء.
هذا كلُّه في القياس، وقد عرفنا أنَّ المنهيَّ عنه لا يعمل به الإماميَّة، وما يعملون به ليس منهيًّا عنه.
وأمَّا الاستحسان فهو عبارة أُخرى عن العمل بالرأي، وليس شيئاً آخر يختلف عنه، فالفقيه حينما يُفتي بحكم غير مستند إلى دليل نقليٍّ ولا عقليٍّ فقد يستند إلى ما يراه مناسباً من وجهة نظره هو، أي إنَّه يُفتي بما يراه حَسَناً بحسب نظره، فقولك: (فلان استحسن كذا) يعني: أنَّه وجده حسناً من وجهة نظره.
ومن ضروريَّات مذهب الإماميَّة حرمة العمل بالاستحسان، كحرمة العمل بالقياس المستنبط العلَّة، ولا يتسامحون فيه فيما لو وقع من أحدٍ منهم ولو عن غفلةٍ، لئلَّا يحصل منه تهاونٌ من هذه الجهة.
وبهذا نختم الكلام على المحطَّة الأُولى التي خصَّصناها للرَّدِّ على احتجاج منكري التقليد بالروايات الدَّالَّة على حرمة العمل بالاجتهاد، والرأي، والقياس، والاستحسان، ويقع الكلام الآن في المحطَّة الثانية.
المحطَّة الثانية: في الاحتجاج بكلمات بعض الأعلام:
لقد نسب منكرو التقليد في منشورهم إلى جملة من أعلامنا القدماء أنَّهم يقولون بحرمة القياس، والاستحسان، والرَّأي، والاجتهاد، والتقليد.
وجوابه: في نقاط ثلاث:
1 - أمَّا تحريم العمل بالقياس والاستحسان والرَّأي فقد ذكرنا سابقاً أنَّه ممَّا أجمع عليه الإماميَّة قاطبةً تبعاً لأئمَّة الهدى (عليهم السلام)، حتَّى صار تحريمها من معالم مذهبنا، ولا يوجد فقيه منَّا يقول بمشروعيَّة شيءٍ من الثلاثة، كي يحتجَّ منكرو التقليد علينا بتحريم الأعلام لها.
2 - وأمَّا مقصود الأعلام من الاجتهاد الذي حرَّموه فهو الاجتهاد بالمعنى الذي حرَّمته الرِّوايات، وهو مغاير تماماً للاجتهاد الذي يقول الإماميَّة بمشروعيَّته، كما أوضحناه في المحطَّة الأُولى بشكل تفصيلي، فما حرَّمته الرِّوايات نحن نقول بتحريمه أيضاً تبعاً لأئمَّتنا (عليهم السلام)، وما نقول بمشروعيَّته لم تُحرِّمه الرِّوايات مطلقاً.
3 - وأمَّا التقليد فله معنيان:
أحدهما: ما هو المقصود منه في الرِّوايات التي حرَّمته.
ثانيهما: ما هو المقصود في بحثنا هذا، والذي يقول الإماميَّة بمشروعيَّته.
والتقليد الذي يُحرِّمه الأعلام هو ما كان بالمعنى الذي حرَّمته الرِّوايات، وأمَّا التقليد بالمعنى الذي نقول بمشروعيَّته فلم يُحرِّموه، بل صرَّحوا بمشروعيَّته، فما نسبه إليهم منكرو التقليد من التحريم إمَّا أْن يكون عن جهل مطبق، أو عن جُرأةٍ على الله تعالى عظيمة، كما سيتَّضح ذلك بعد نقل كلمات الأعلام الذين نسبوا إليهم القول بحرمة التقليد، والجواب عليها.
والأعلام المنسوب إليهم تحريمه خمسة، ونحن ننقل هنا كلام ثلاثةٍ منهم، وهم المفيد، والطوسي، والمحقِّق الحلّيِّ (قدَّس الله أسراهم)(26).
كلمة الشيخ المفيد:
قال الشيخ المفيد (قدّس سرّه) - حسب منشور منكري التقليد -: قال الصادق (عليه السلام): «إيَّاكم والتقليد، فإنَّه من قلَّد في دينه هلك، إنَّ الله تعالى يقول: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللهِ﴾، فلا والله ما صلُّوا لهم وما صاموا، ولكنَّهم أحلُّوا لهم حراماً وحرَّموا عليهم حلالاً، فقلَّدوهم في ذلك، فعبدوهم وهم لا يشعرون».
وقال (عليه السلام): «من أجاب ناطقاً فقد عبده، فإنْ كان الناطق عن الله تعالى فقد عبد الله، وإنْ كان الناطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان».
وقال الناشر: ثمَّ علَّق الشيخ المفيد قائلاً: فصلٌ: ولو كان التقليد صحيحاً والنظرُ باطلاً لم يكن التقليد لطائفةٍ أولى من التقليد لأُخرى، وكان كلُّ ضالٍّ بالتقليد معذوراً، وكلُّ مقلِّدٍ لمُبدعٍ غيرَ موزورٍ، وهذا ما لا يقوله أحد، فعُلِمَ بما ذكرناه أنَّ النظر هو الحقُّ، والمناظرة بالحقِّ صحيحةٌ(27).
هذا ما نقله منكرو التقليد في منشوراتهم عن الشيخ المفيد (قدّس سرّه).
وجوابه: في أربع نقاط:
1 - أنَّ الشيخ المفيد (قدّس سرّه) ذكر هذا الكلام في كتابه (تصحيح اعتقادات الإماميَّة) الذي ألَّفه للردِّ على الشيخ الصدوق (قدّس سرّه) في بعض ما ذهب إليه في كتابه (اعتقادات في دين الإماميَّة)، ومن ذلك تحريمه الجدال في الله تعالى، فردَّ عليه المفيد بأنَّ المنهيَّ عنه هو الجدال بالباطل فقط، وأمَّا الجدال بالحقِّ فهو مأمور به، واستدلَّ على ذلك بعدَّة نصوص، منها الحديثان اللذان اقتصر على نقلهما منكرو التقليد، ولا علاقة للكتابين ولا لكلام الشيخين بباب الأحكام الفرعيَّة أصلاً!
2 - أنَّ الناشر قال: (ثمَّ علَّق الشيخ المفيد قائلاً: فصل...)، وهذا دليل على جهله، لأنَّ كلمة (فصل) تُستَعمل في الكُتُب - لاسيّما القديمة منها - للفصل بين كلام وآخر مختلفٍ عنه، والمفيد (قدّس سرّه) بعد أنْ تمسَّك بالدليل النقلي ختم المبحث بدليل عقليٍّ، وفَصَله عن النصوص ليكون دليلاً مستقلّاً برأسه.
وقد بيَّن في هذا الدليل: أنَّ التقليد لو جاز لطائفةٍ لجاز لطائفةٍ أُخرى، فلو حرَّمنا على المسلم - مثلاً - الجدال في الله تعالى وجوَّزنا له تقليد آبائه في دين الإسلام للزم أنْ نُجوِّز للملحد أنْ يُقلِّد آباءه في الإلحاد أيضاً، وحيث إنَّ هذا قبيح عقلاً فيلزم أنْ يكون الاعتقاد من خلال الفكر والاستدلال، لا من خلال التقليد.
هذا هو مقصوده من التقليد المحرَّم، وهو ما كان في أُصول الاعتقاد، وأين هذا من التقليد في الأحكام الفرعيَّة؟!
3 - أنَّ المفيد (قدّس سرّه) قال بعد ذلك: (فعُلِمَ بما ذكرناه أنَّ النظر هو الحقُّ، والمناظرة بالحقِّ صحيحةٌ)، ثمَّ عطف عليه قوله: (وأنَّ الأخبار التي رواها أبو جعفر (قدّس سرّه) وُجُوهُها (وفي نسخة: جَوَابُها) ما ذكرناه، وليس الأمر في معانيها على ما تخيَّله فيها)(28).
يعني: أنَّ ما ذكره هو من جواز الجدال بالحقِّ هو الصحيح، وأنَّ الأخبار التي نقلها الصدوق (قدّس سرّه) قد تخيَّل أنَّها تدلُّ على حرمة الجدال في الله مطلقاً حتَّى لو كان جدالاً بالحقِّ، والحال أنَّها ناظرة إلى الجدال بالباطل فقط.
هذا ما أراد بيانه الشيخ المفيد، ولكن الناشر حذف هذه الجملة من المقطع بجهلٍ أو تدليس منه، حيث إنَّها تُؤكِّد أنَّ الكلام من أوَّله إلى آخره كان في باب الاعتقادات، ولا تعرُّض فيه لباب التقليد في الأحكام الفقهيَّة أصلاً!
4 - أنَّ الشيخ المفيد (قدّس سرّه) هو ممَّن يقول بمشروعيَّة التقليد في الفروع قطعاً، فإنَّه من مشاهير المفتين في تاريخ المسلمين، وله في ذلك عدَّة مؤلَّفات، منها كتابه الشهير المسمَّى بـ(المقنعة) وهو رسالته العمليَّة، وله رسائل عديدة في أجوبة الاستفتاءات لمقلِّديه.
كلام الشيخ الطوسي:
قال الشيخ الطوسي (قدّس سرّه) - حسب نقل الناشر -: (التقليد إنْ أُريد به قبول قول الغير من غير حجَّة وهو حقيقة التقليد فذلك قبيح في العقول، لأنَّ فيه إقداماً على ما لا يأمنُ كونَ ما يعتقده عند التقليد جهلاً، لِتعَرِّيه من الدليل، والإقدامُ على ذلك قبيحٌ في العقول، ولأنَّه ليس في العقول تقليدُ الموحِّدِ أولى من تقليد الملحد إذا رفعنا النظر والبحث عن أوهامنا، ولا يجوز أنْ يتساوى الحقُّ والباطل)(29).
وجوابه: من وجوه ثلاثة:
1 - أنَّ الشيخ (قدّس سرّه) قال ذلك في كتابه (الاقتصاد) وهو قسمان: أوَّلهما: في الأُصول الاعتقاديَّة، وثانيهما: في العبادات الشرعيَّة، والمقطع المذكور منقول من القسم الأوَّل، فهو ناظر إلى التقليد في العقائد، حيث إنَّه بعد حصره العلم بالله تعالى بطريق الاستدلال ذكر إشكالاً هذا نصُّه: (فإنْ قيل: أين أنتم عن تقليد الآباء والمتقدِّمين؟)، وأجاب عليه بما نصُّه: (قلنا: التقليد إنْ أُريد به قبول قول الغير من غير حجَّة وهو حقيقة التقليد فذلك قبيح في العقول...) إلى آخر عبارته التي نقلها منكرو التقليد، والتي هي واردة في باب العقائد، كما هو صريح الاستدلال في قوله: (ولأنَّه ليس في العقول تقليدُ الموحِّدِ أولى من تقليد الملحد).
ولو تأمَّلتم قليلاً فهو عين الدليل العقلي الذي ذكره أُستاذه الشيخ المفيد آنفاً، ولكنَّه صاغه بصياغة أُخرى حاصلها: أنَّه لو جوَّزنا لشخصٍ أنْ يُقلِّد أهله الموحِّدين في عقيدة التوحيد لوجب أنْ نُجوِّز لشخص آخر أنْ يُقلِّد أهله الملحدين في الإلحاد، وهو قبيح عقلاً.
2 - أنَّ الطوسي (قدّس سرّه) من مشاهير المُفتين عند جميع المسلمين، وله كُتُب فتوائيَّة عديدة ألَّفها لرجوع المؤمنين إليها، ومن بينها الكتاب المذكور في قسمه الثاني، وكتاب (المبسوط)، وكتاب (النهاية)، وغيرها.
3 - أنَّ الطوسي (قدّس سرّه) يُصرِّح بمشروعيَّة التقليد في كتابه (العُدَّة)، حيث قال: (والذي نذهب إليه أنَّه يجوز للعامِّيِّ الذي لا يقدر على البحث والتفتيش تقليد العالِم).
ثمَّ استدلَّ على الجواز بما نصُّه: (يدلُّ على ذلك: أنّي وجدتُ عامَّةَ الطائفة من عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى زماننا هذا يرجعون إلى علمائها، ويستفتونهم في الأحكام والعبادات، ويفتونهم العلماء فيها، ويُسوِّغون لهم العمل بما يفتونهم به، وما سمعنا أحداً منهم قال لمُستَفْتٍ: لا يجوز لك الاستفتاء، ولا العمل به، بل ينبغي أنْ تنظر كما نظرتُ، وتعلم كما عَلِمتُ، ولا أنكَرَ عليه العمل بما يفتونهم، وقد كان الخَلقُ العظيمُ عاصرو(عليهم السلام)، ولم يُحكَ عن واحدٍ من الأئمَّة النكير على أحد من هؤلاء، ولا إيجاب القول بخلافه، بل كانوا يُصَوِّبونهم في ذلك، فمن خالفه في ذلك كان مخالفاً لما هو المعلوم خلافه)(30).
وها أنت ترى كيف جعل (قدّس سرّه) المخالف للجواز مخالفاً لما هو المعلوم من جواز التقليد، وكلامه ظاهر في أنَّه يستند في الجواز إلى الإجماع العملي بين الإماميَّة على جوازه.
كلام المحقِّق الحلِّي:
قال المحقِّق الحلِّي (قدّس سرّه): (التقليد قبول قول الغير من غير حجَّة، فيكون جزماً في غير موضعه، وهو قبيح عقلاً)(31).
وجوابه: من وجهين:
1 - أنَّ المحقِّق (قدّس سرّه) إنَّما ذكر ذلك في القسم المخصَّص لأُصول العقائد من كتابه (المعارج)، حيث قال في موضع منه: (المسألة الثانية: لا يجوز تقليد العلماء في أُصول العقائد)(32)، ثم استدلَّ على عدم الجواز بعدَّة وجوه، منها قوله: (الثاني: أنَّ التقليد: قبولُ قولِ الغير من غير حُجَّةٍ، فيكون جزماً في غير موضعه، وهو قبيح عقلاً)(33).
وهذه هي العبارة التي دلَّس بها منكرو التقليد على المؤمنين، حيث لم ينقلوا عبارته الأُخرى التي ذكرها في موضع آخر من نفس الكتاب، وهي صريحة في جواز التقليد في الفروع، حيث قال ما نصُّه: (المسألة الأُولى: يجوز للعامِّيِّ العمل بفتوى العالم في الأحكام الشرعيَّة).
ثمَّ استدلَّ (قدّس سرّه) على الجواز - بعد أنْ نقل قول المخالفين كالمعتزلة - وقال ما نصُّه: (لنا: اتِّفاق علماء الأعصار على الإذن للعوامِّ في العمل بفتوى العلماء من غير نكير).
وكان هذا دليله الأوَّل، ثمَّ استدلَّ بدليل ثانٍ وقال: (الثاني: لو وَجَبَ على العامِّي النظر في أدلَّة الفقه لكان ذلك إمَّا قبل وقوع الحادثة أو عندها، والقسمان باطلان، أمَّا قبلها فمنفيٌّ بالإجماع، ولأنَّه يُؤدِّي إلى استيعاب وقته بالنظر في ذلك، فيُؤدِّي إلى الضَّرر بأمر المعاش المضطرِّ إليه، وأمَّا بعد نزول الحادثة فذلك متعذِّر، لاستحالة اتِّصاف كلِّ عامِّيٍّ عند نزول الحادثة بصفة المجتهدين)(34).
ولا يخفى على من يتأمَّل في دليله الثاني أنَّه يدلُّ على وجوب التقليد على العوامِّ، لا مجرَّد جوازه.
2 - أنَّ المحقِّق الحلِّي هو من أكابر المفتين بين علماء المسلمين، وله جملة رسائل في أجوبة الاستفتاءات، ناهيك عن رسالته العمليَّة الشهيرة باسم (شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام) التي ألَّفها ليعمل بها العوامُّ، ولهذا الكتاب شهرة واسعة حتَّى عند علماء المخالفين، فكيف يقول بعد كلِّ هذا بتحريم التقليد؟!
والنتيجة: قد اتَّضح من كلِّ ذلك أنَّ ما نُسِبَ إلى هؤلاء الأعلام من تحريمهم للتقليد كذبٌ فاضح، أو جهل مطبق.
الصنف الثاني: ما دلَّ على حرمة التقليد:
وقد استدلُّوا بروايات زعموا دلالتها على حرمة التقليد، فلابدَّ من استعراضها، ثمَّ الجواب على استدلالهم بها.
الرواية الأُولى: قالوا: (كتب الحُرُّ العاملي صاحب وسائل الشيعة باباً كاملاً تحت عنوان (باب: عدم جواز تقليد غير المعصوم (عليه السلام)...) ذكر فيه عدداً كبيراً من الروايات التي جاءت تنهى عن تقليد غير المعصوم).
ثمَّ نقلوا هذه الرواية وقالوا ما نصُّه: عن محمّد بن خالد، عن أخيه، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إيَّاك والرئاسة، فما طلبها أحد إلَّا هلك»، فقلت: قد هلكنا إذاً، ليس أحد منّا إلَّا وهو يُحِبُّ أنْ يُذكَرَ، ويُقصَدُ، ويُؤخَذَ عنه، فقال: «ليس حيث تذهب، إنَّما ذلك أنْ تنصب رجلاً دون الحجَّة، فتُصدِّقه في كلِّ ما قال، وتدعو الناس إلى قوله»(35).
والجواب من وجهين:
1 - أنَّهم لو أكملوا عنوان الباب المذكور لانكشف تدليسهم، وهذا تمام العنوان: (باب: عدم جواز تقليد غير المعصوم (عليه السلام) فيما يقول برأيه، وفيما لا يعمل فيه بنصٍّ عنهم (عليهم السلام))(36).
فإنْ عرفت ما حذفوه عرفت ما أخفوه، فقد أخفوا عبارة: (فيما يقول برأيه، وفيما لا يعمل فيه بنصٍّ عنهم (عليهم السلام)).
وهذا يعني: عدم جواز تقليد شخص غير معصوم في فتاوى يستند فيها إلى رأيه هو، لا إلى الكتاب ولا إلى أحاديث المعصومين (عليهم السلام)، وكذلك يُقلِّده فيما يترك فيه نصَّ المعصوم (عليه السلام) ولا يعمل به.
ولا أدري ما علاقة هذا العنوان بفقهائنا الذين أجمعوا على حرمة العمل بالرَّأي تبعاً لأئمَّة أهل البيت (عليهم السلام) كما أوضحناه سابقاً؟!
وأين هذا من قومٍ أجمعوا على وجوب العمل بنصوص المعصومين (عليهم السلام) وحرمة مخالفتها؟!
ونحن عوامُّ الشيعة أيضاً نرفض تقليد كلِّ من يعمل برأيه تاركاً العمل بالكتاب وأحاديث أهل العصمة (عليهم السلام)، كما نرفض تقليد كلِّ من يترك العمل بنصِّ المعصوم (عليه السلام).
2 - أنَّ الرِّواية لا علاقة لها بفقهاء الشيعة ومقلِّديهم لا من قريب ولا من بعيد، اللَّهُمَّ إلَّا إذا تركنا عقولنا جانباً وقرأناها بعقول منكري التقليد التي تقرأ الرِّوايات بعقول منكوسة.
توضيح ذلك: أنَّ الإمام (عليه السلام) قال: «أنْ تنصب رجلاً دون الحُجَّة فتُصدِّقه في كلِّ ما قال، وتدعو الناس إلى قوله»، فذكر (عليه السلام) ثلاثة عناصر:
العنصر الأوَّل: أنْ ينصب المكلَّف من عند نفسه رجلاً ويتَّخذه مرجعاً في كلِّ ما يقول، ولا يتَّخذ من نصبه الله تعالى، أو رسولُهُ (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، أو الإمامُ (عليه السلام).
ومن البديهيَّات والواضحات أنَّ هذا المعنى مرفوضٌ عند المقلِّدين من عوامِّ الشيعة، فكيف طبَّقوا الحديث عليهم؟!
العنصر الثاني: أنَّ المنصوب في الرِّواية من كان دون الحجَّة، أي ليس هو معصوماً، ولا منصوباً من قِبَل الله تعالى أو المعصوم (عليه السلام).
وهذا لا ينطبق على عوامِّ الشيعة في رجوعهم إلى الفقهاء، لأنَّ الرجوع إليهم ممَّا قام الدليل الشرعي عليه كما ثبت بالدليل الشرعي، ومن الواضح أنَّ كلَّ من قام الدليل على جواز تقليده فقوله حُجَّة، وكان اتِّباع المقلِّد له داخلاً في باب الأخذ ممَّن هو حُجَّة، وأين هذا من مدلول الرواية الشريفة؟!
العنصر الثالث: أنَّ المتفرِّع على كون الرجل المنصوب حجَّةً هو تصديقه في كلِّ ما يقول، وهذا يعني أنْ يكون المقصود: نصبَ رجلٍ بمثابة الإمام، كأبي حنيفة وأشباهه، بحيث يُصدِّقه أتباعه في كلِّ ما يقول ويُفتي به.
ومن المعلوم أنَّ حالنا - نحن العوامِّ - مع فقهائنا ليس كذلك، لأنَّ الفقيه تارةً يكون في مقام الرِّواية عن المعصوم (عليه السلام)، وفي هذه الحال إنَّما نأخذ عنه باعتباره راوياً ثقةً ينقل لنا الحكم عن إمامنا (عليه السلام)، كما كان يصنع زرارة بن أعين، ومحمّد بن مسلم، وأبو بصير، وأمثالهم من رواتنا الثقاة.
وتارةً يكون في مقام الفتوى وبيان ما فهمه من أحاديثهم (عليهم السلام)، وفي هذه الحال إنَّما نأخذ عنه باعتباره ممَّن أمرن(عليهم السلام) بالرجوع إليه في الفتاوى، فيكون رجوعنا إليه في باب الفتاوى امتثالاً لما أمرنا به أئمَّتنا (عليهم السلام).
مثال الحالتين: ما لو روى زرارة حديثاً عن الإمام الباقر (عليه السلام) فإنَّنا مأمورون من قِبَل الأئمَّة (عليهم السلام) بتصديقه، ووجوب أخذ الحديث عنه، لأنَّ ما نقله إلينا إنَّما هو كلامهم (عليهم السلام)، وليس كلامه هو، إذ ليس هو إلَّا مجرَّد ناقل.
ولو كان الحديث الذي نقله عن المعصوم (عليه السلام) يشتمل على حكم شرعيٍّ لا نتمكن من استنباطه من الحديث، فعند ذلك نسأل زرارة عن مقصود الإمام الباقر (عليه السلام)، فإنْ أوضحه لنا وجب علينا الأخذ بفهمه، لكونه من الفقهاء الذين أرجع أهل البيت (عليهم السلام) المؤمنين لأخذ الفتاوى عنه وعن أمثاله.
والنتيجة: أنَّ هذه الرواية ناظرة إلى مسلك المخالفين ومن سلك سبيلهم من جهلة الشيعة، كمن نسمع عنهم في هذه الأيّام ممَّن يهرولون وراء العناوين البرَّاقة، ومن دون أنْ يرجعوا إلى أهل الخبرة في ذلك.
الرواية الثانية: ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللهِ﴾ [التوبة: 31]، فقال: «أمَا والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم، ولو دعوهم ما أجابوا، ولكن أحلُّوا لهم حراماً، وحرَّموا عليهم حلالاً، فعبدوهم من حيث لا يشعرون»(37).
ولم يذكر منكرو التقليد كيفيَّة الاستدلال بهذه الرواية على حرمة تقليدنا للفقهاء، ونحن نساعدهم في ذلك، فنقول:
إنَّ الاستدلال بالرِّواية على حرمة التقليد يتمُّ بتماميَّة مقدِّمتين:
المقدِّمة الأُولى: أنَّ ظاهر الرِّواية أنَّ أبا بصير سأل من الإمام (عليه السلام): كيف يتَّخذ أهلُ الكتاب علماءَهم - الأحبار والرُّهبان - أرباباً من دون الله، مع أنَّهم يعتقدون بأنَّ العلماء مخلوقون لله تعالى؟
فأجابه الإمام (عليه السلام): ليس المقصود أنَّهم يعبدونهم من دون الله كما يصنع عبدة الأوثان وأشباههم، بل المقصود أنَّهم أطاعوهم في فتاواهم المخالفة لأحكام الله تعالى، فإنَّهم قد أحلُّوا لهم الحرام، وحرَّموا عليهم الحلال، فأخذوا بتلك الفتاوى المخالفة لأحكامه (عزَّ وجلَّ)، والقرآن عبَّر عن هذه المتابعة فيما يخالف أحكامه تعالى باتِّخاذهم أرباباً من دون الله.
والمفهوم من ذلك: أنَّ متابعة عوامِّ أهل الكتاب لعلمائهم هي بمثابة اتِّخاذهم أرباباً من دون الله، وفي هذا دلالة على أنَّ هذه المتابعة محرَّمة حرمةً شديدةً ومغلَّظةً، لأنَّها بمنزلة الشرك بالله سبحانه.
المقدِّمة الثانية: أنَّ الفقيه يُخطئ ويُصيب في فتاواه، وهذا يعني أنَّه في حال الخطأ يكون قد أفتى بخلاف حكم الله، فلو أخذ العوامُّ بجميع فتاواه فذلك يعني أنَّهم قد أخذوا بتلك الفتاوى المخالفة لأحكام الله، ويكونون كأهل الكتاب الذين يأخذون من علمائهم ما يخالف حكم الله تعالى، ما يعني أنَّ تقليد العوامِّ للفقهاء في جميع فتاواهم محرَّم، وبمنزلة الشرك بالله (عزَّ وجلَّ).
والجواب على هذا الاستدلال من وجهين:
1 - أنَّ الرواية ظاهرة في أنَّ الأحبار والرهبان كانوا يتعمَّدون مخالفة أحكام الله (عزَّ وجلَّ)، والقرآن الكريم والتاريخ الصحيح يشهدان بذلك أيضاً، وهل هناك مخالفة متعمَّدةٌ أكبر من إنكارهم نبوَّة نبيِّنا (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، مع علمهم اليقيني بأنَّه هو النبيُّ الذي يجدونه مذكوراً في التوراة والإنجيل؟
وأين هذا من مراجعنا الذين نشترط فيهم العدالة التي هي وبشرح مبسَّط (صفة راسخة في النفس تدعو إلى الاستقامة في جادَّة الشريعة، وعدم الميل عنها يمنةً أو يسرةً)، ومن كانت هذه صفته كيف يتعمَّد مخالفة أحكام الله تعالى؟!
2 - قد روي عن الإمام الصادق (عليه السلام) حديثٌ شارحٌ لهذه الرِّواية، وهو يدلُّ دلالة صريحة على أنَّ عوامَّ أهل الكتاب كانوا يُقلِّدون علماءهم وهم يعلمون بفسقهم، ويعلمون بأنَّهم لا يتورَّعون عن الكذب، فقد نُقِلَ في الوسائل عن الطبرسي في كتاب (الاحتجاج)، عن أبي محمّد العسكري (عليه السلام)، في قوله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللهِ﴾ [البقرة: 79]، قال (عليه السلام): «هذه لقومٍ من اليهود...».
إلى أنْ قال: وقال رجل للصادق (عليه السلام): إذا كان هؤلاء العوامُّ من اليهود لا يعرفون الكتاب إلَّا بما يسمعونه من علمائهم فكيف ذمَّهم بتقليدهم والقبول من علمائهم، وهل عوامُّ اليهود إلَّا كعوامِّنا يُقلِّدون علمائهم؟
إلى أنْ قال(38): فقال (عليه السلام): «بين عوامِّنا وعوامِّ اليهود فرقٌ من جهة، وتسويةٌ من جهة. أمَّا من حيث الاستواء فإنَّ الله ذمَّ عوامَّنا بتقليد علمائهم كما ذمَّ عوامَّهم. وأمَّا من حيث افترقوا فإنَّ عوامَّ اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصُّراح، وأكل الحرام والرُّشاء، وتغيير الأحكام، واضطُرُّوا بقلوبهم إلى أنَّ من فعل ذلك فهو فاسق لا يجوز أنْ يُصدَّق على الله، ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله، فلذلك ذمَّهم. وكذلك عوامُّنا إذا عرفوا من علمائهم الفسقَ الظاهر، والعصبيَّةَ الشَّديدة، والتكالبَ على الدنيا وحرامها، فمن قلَّد مثل هؤلاء فهو مثل اليهود الذين ذمَّهم الله بالتقليد لِفَسَقَةِ علمائهم، فأمَّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً على هواه، مطيعاً لأمر مولاه فللعوامِّ أنْ يُقلِّدوه، وذلك لا يكون إلَّا بعض فقهاء الشيعة لا كلُّهم، فإنَّ من ركب من القبايح والفواحش مراكبَ علماء العامَّة فلا تقبلوا منهم عنَّا شيئاً ولا كرامة، وإنَّما كثر التخليط فيما يُتحمَّل عنَّا أهل البيت لذلك، لأنَّ الفَسَقَة يتحمَّلون عنَّا فيُحرِّفونه بأسره لجهلهم، ويضعون الأشياء على غير وجهها، لقلَّة معرفتهم، وآخرون يتعمَّدون الكذب علينا»(39).
إنَّ هذا الحديث الطويل حجَّة دامغة على كلِّ من يقبل روايات الوسائل، ولا يناقش في أسانيدها.
وخلاصته: أنَّ التقليد المحرَّم هو تقليد العلماء المعروفين بالكذب، والفسق، والتَّكالُب على الدنيا، سواء كانوا من اليهود، أم النصارى، أم المسلمين، وأمَّا تقليد العلماء الصائنين لأنفسهم، الحافظين لدينهم، المخالفين لأهوائهم، المطيعين لأمر مولاهم، فهو خارج عن الآية المباركة.
ومن هذا الحديث يتَّضح أنَّ رواية (الكافي) تختصُّ بتقليد من يخالف أحكام الله تعالى عن علم وعمد، كعلماء السُّوء، ووُعَّاظ السلاطين الذين يكثر أمثالهم في أحبار اليهود، ورُهبان النَّصارى، وفقهاء العامَّة، والفُسَّاق من فقهاء الشيعة، كما صرَّح به الحديث المذكور في قوله: «وذلك لا يكون إلَّا بعض فقهاء الشيعة لا كلُّهم»، بخلاف فقهائنا الورعين الأتقياء، فإنَّهم خارجون عن حديث (الكافي).
الصنف الثالث: ما دلَّ على أنَّ الفقيه إذا أخطأ في حكمه فقد كفر، أو حَكَم بحكم الجاهليَّة:
ويشتمل هذا الصنف على روايتين:
الرواية الأُولى: قال أبو جعفر (عليه السلام): «من حكم في درهمين فأخطأ كفر»(40).
الرواية الثانية: قال الصادق (عليه السلام): «الحُكم حُكمان: حكم الله، وحكم الجاهليَّة، فمن أخطأ حكم الله حكم بحكم الجاهليَّة»(41).
والجواب من ثلاثة وجوه:
1 - أنَّ الرِّوايتين واردتان في باب القضاء، ولا ملازمة بينه وبين باب الإفتاء، وربَّما يلتزم فقيهٌ بحرمة القضاء إلَّا عند القطع بمطابقة حكمه لحكم الله تعالى، ولا يتصدَّى للحكم فيما إذا لم يحصل له يقين بحكم الله تعالى، وهذا لا يستلزم حرمة الإفتاء بالشكل الذي أمر به أهل البيت (عليهم السلام)، كما عرفت في البحوث السابقة.
2 - قد تواتر أنَّ النبيَّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وأمير المؤمنين (عليه السلام) والحسن (عليهما السلام) قد نصبوا قضاةً، ومن المعلوم أنَّ القضاة يُخطئون ويُصيبون في أحكامهم، ولم ينقل تاريخ المسلمين ولا روايات الفقه عند الفريقين أنَّ المعصوم حكم بكفر قاضٍ أخطأ في حكمه بغير تعمُّد منه، فما يجيب به منكرو التقليد على هذا فهو جوابنا عليهم فيما لو أخطأ قاضٍ من قضاة الشيعة اليوم في حكمه لا عن تعمُّد.
3 - أنَّ استدلالهم بهاتين الروايتين هو استدلال بالإطلاق، ومن المعلوم أنَّه لا يجوز الأخذ بالإطلاق إلَّا بعد اليأس من العثور على ما يُقيِّده، ولو رجعنا إلى روايات الباب لوجدناها تُقيِّد الروايتين بما إذا كان الحكم حكماً بغير ما أنزل الله تعالى، فالحكم بغير ما أنزل الله هو الكفر، وهو حكم الجاهليَّة.
فمنها: ما روي عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «الحكم حكمان: حكم الله، وحكم الجاهليَّة، وقد قال الله (عزَّ وجلَّ): ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة: 50]، واشهدوا على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهليَّة»(42).
وهي واضحة في أنَّ زيد بن ثابت ترك حكم الله في باب المواريث عن عمد وحكم بغيره، فكان حكمه حكم الجاهليَّة.
وأين هذا من منهج فقهائنا في الفقه ومنه كتاب المواريث؟ فإنَّهم لا يُفتون فيه بشيءٍ ما لم يكن وارداً في كتاب الله، أو روايات المعصومين (عليهم السلام).
ومنها: ما رواه أبو بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، وابنُ أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قالا: «من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله (عزَّ وجلَّ) ممَّن له سوط أو عصا فهو كافر بما أنزل الله (عزَّ وجلَّ) على محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم)»(43).
ومنها: ما رواه أبو بصير، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فهو كافر بالله العظيم»(44).
ومنها: ما رواه عبد الله بن مسكان، رفعه، قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): «من حكم في درهمين بحكم جورٍ، ثمَّ جَبَرَ عليه كان من أهل هذه الآية: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ﴾ [المائدة: 44]»، فقلت: وكيف يجبر عليه؟ فقال: «يكون له سوط وسجنٌ، فيحكم عليه، فإذا رضي بحكومته، وإلَّا ضربه بسوطه، وحبسه في سجنه»(45).
ومن الواضح لكلِّ عاقل أنَّ هذه الروايات الثلاث واردة في قضاة الجور والمعرضين عن أحكام الإسلام، فهي أجنبيَّة عن فقهائنا بالمرَّة.
وبعد كلِّ هذه المقيِّدات يدير المستدلُّ ظهره عنها بعمدٍ، أو جهلٍ، ويأخذ بإطلاق الروايتين المتقدِّمتين.
الصنف الرابع: ما دلَّ على أنَّ مقلِّدي الفقهاء أعداء للدِّين وللقائم (عجّل الله فرجه):
نقلنا في روايات الصنف الأوَّل ما نسبوه إلى إمامنا الصادق (عليه السلام) من أنَّه ذكر الإمام المهدي (عجّل الله فرجه) وقال: «أعداء الدِّين مقلِّدة الفقهاء أهل الاجتهاد ولم يرونه يحكم بخلاف ما ذهب إليه أئمَّتُهم...» إلخ.
ولأجل اشتمال الرواية على ذكر الفقهاء بعبارة (أهل الاجتهاد) فقد أدرجناها في الصنف الأوَّل الذي خصَّصناه للرِّوايات التي استدلُّوا بها على حرمة الاجتهاد، ولأجل اشتمالها على ذكر المقلِّدين بعبارة (مقلِّدة الفقهاء) فهي تندرج في روايات هذا الصنف أيضاً.
وقد أجبنا على هذه الرِّواية هناك مفصَّلاً بعدَّة أجوبة، وكان أهمُّها أنَّها مكذوبةٌ على إمامنا الصادق (عليه السلام)، وأثبتنا هناك وبالأرقام أنَّها من كلام ابن عربي الصوفي المعروف، وليس من كلام إمامنا الصادق (عليه السلام)(46).
الصنف الخامس: ما دلَّ على حرمة العمل بالظنِّ:
طالما سمعنا وما زلنا نسمع أنَّ الأحكام التي يُفتي بها الفقهاء ما هي إلَّا أحكام ظنّيَّة، وأنَّ أحكام المعصومين (عليهم السلام) ليست كذلك، بل هي قطعيَّةٌ.
وهذا الكلام ناشيءٌ من الجهل بشريعة الإسلام وأحكامه بصورة عامَّة، وبما هو مقصود النصوص الناهية عن العمل بالظنِّ بصورة خاصَّة.
مضافاً إلى الجهل بمعنى ظنِّيَّة الأحكام وقطعيَّتها، كما سيتَّضح هذا كلُّه فيما يأتي إنْ شاء الله تعالى.
وممَّا استدلُّوا به لهذا الصِّنف ما نقلوه عن المفضَّل بن عمر، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «من شكَّ أو ظنَّ فأقام على أحدهما فقد حبط عمله، إنَّ حجَّة الله هي الحُجَّةٌ الواضحة»(47).
ونحن بدورنا نتبرَّع لهم بما هو أقوى من الرِّواية المذكورة، أعني الآيات الكريمة الناهية عن اتِّباع الظنِّ، كقوله تعالى: ﴿وَما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾ (النجم: 28)، وقوله سبحانه: ﴿وَما يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِما يَفْعَلُونَ﴾ (يونس: 36)، وقوله (عزَّ وجلَّ): ﴿وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ (الأنعام: 116)، وقوله (عزَّ من قائل): ﴿وَلَا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً﴾ (الإسراء: 36).
ونحن نُجيب أوَّلاً على الاستدلال برواية المفضَّل، ثمّ على الاستدلال بالآيات الكريمة.
والجواب على الرِّواية من أربعة وجوه:
1 - أنَّها مرسَلة، فقد نقلها صاحب الوسائل عن الكافي، والكليني رواها عن المفضَّل من دون سند، قال (قدّس سرّه): (وفي وصيَّة المفضَّل، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:...) الحديث(48).
وهذا يعني أنَّ صدور الرِّواية من الإمام (عليه السلام) مشكوكٌ فيه، وعلى أفضل التقادير يكون مظنوناً، والظَّنِّيُّ ليس حجَّة عندهم، فلا يصحُّ الاستدلال بها على بطلان فتاوى الفقهاء الظنّيَّة.
2 - لو تنزَّلنا وفرضنا القطع بصدورها فهو لا ينفع المستدلَّ بها على حرمة العمل بالظنِّ، لأنَّ الكليني (قدّس سرّه) أوردها في كتاب الكفر والإيمان في بابٍ عنونه بعنوان (الشَّكِّ)، وقد نقل في هذا الباب تسع روايات إحداها هذه الرِّواية، والثمانية الأُخرى كلُّها تتحدَّث عن الشَّكِّ والظنِّ المقابلين للإيمان واليقين، والموجبان للكفر.
وهذا يعني أنَّ الكلينيَّ (قدّس سرّه) فهم أنَّ المراد من الشَّكِّ والظنِّ في روايتنا هو عين المراد منهما في الرِّوايات الثمانية الأُخرى، ولا علاقة لهما بباب الأحكام الشرعيَّة أصلاً.
3 - لو تنزَّلنا وفرضنا أنَّ ذكر الكليني لها في باب الكفر والإيمان لا يجعلها مختصَّةً بذلك الباب فهو لا ينفع المستدلَّ بها أيضاً، إذ لا أقلَّ من أنَّها تصبح مجملةً في دلالتها، لاحتمال أنَّها مختصَّة بباب العقائد، ولا ظهور لها في العموم والشمول لباب الأحكام.
4 - لو تنزَّلنا وفرضنا أنَّها شاملةٌ لباب الأحكام أيضاً فهي مختصَّةٌ بمن يبني على الشَّكِّ أو الظنِّ من دون أنْ يرجع إلى الوظيفة المجعولة من قِبَل الشرع للمكلَّف في حالة الشَّكِّ أو الظنِّ.
وأمَّا لو رجع إلى تلك الوظيفة فهو عامل بما أوجبه الشرعُ، وليس تخرُّصاً من عند نفسه واتِّباعاً لظنِّه الشَّخصيِّ.
والقرينة على أنَّ المقصود في الرِّواية هو من يبني عليهما قوله (عليه السلام): «فأقام على أحدهما»، بمعنى: إنْ بقي واستمرَّ على شكِّه أو ظنِّه، وهذا ينطبق على من لم يرجع إلى تلك الوظيفة، ولا ينطبق على فقهائنا، فإنَّهم لا يعملون في موارد الشَّكِّ والظنِّ إلَّا بما رسمه لهم الشرع من قواعد يرجعون إليها في حالتي الشَّكِّ والظنِّ.
مثاله: لو شكَّ الفقيه في حرمة فعل من الأفعال بعد أنْ بذل كلَّ ما بوسعه في مقام الفحص والبحث عن حكم ذلك الفعل في مصادر التشريع ولم يعثر على ما يدلُّ عليه، فآنذاك يرجع إلى ما تقتضيه القواعد والأُصول المجعولة شرعاً لحالة الشكِّ، كأصالة البراءة مثلاً، والتي دلَّ عليها حديث النبيِّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم): «رفع عن أُمَّتي تسع: الخطأ، والنسيان، وما أُكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطُرُّوا إليه...» الحديث(49).
فقد دلَّت كلُّ واحدة من الفقرات التسع على قاعدة عامَّة يرجع الفقهاء إلى كلِّ واحدة منها في مجالها، ومنها فقرة (ما لا يعلمون) التي تفيد أنَّ الحكم الذي لا يعلم المكلَّف بثبوته بعد أنْ بحث عنه بكلِّ جهده في ثنايا مصادر التشريع حتَّى يئس من العثور عليه فهو حكم مرفوع عنه، بمعنى أنَّ الله تعالى لا يُؤاخذه به لو كان موجوداً في الواقع، وعجز المكلَّف عن الوصول إليه من دون تقصير.
وكذلك أصالة الحلِّ التي دلَّ عليها حديث للإمام الصادق (عليه السلام): «كلُّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حتَّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه»(50).
وغير ذلك من النصوص التي تُحدِّد وظيفةَ المكلَّف في حالة الشَّكِّ في الحكم، أو الظنِّ به.
وهذا يعني أنَّ الفقيه حينما يُفتي بحكم في تلك الحالة إنَّما يحكم بما دلَّ عليه النصُّ، أو الأصل، لا أنَّه يحكم برأيه، أو يبني على شكِّه أو ظنِّه.
والنتيجة: أنَّ رواية المفضَّل أجنبيَّة عن فتاوى فقهائنا.
وأمَّا الجواب على الاستدلال بالآيات الثلاث الأُولى الناهية عن اتِّباع الظنِّ فحاصله: أنَّها واردة في باب العقيدة، وليس فيها أيَّة رائحة في جانب الأحكام الشرعيَّة.
أمَّا قوله تعالى: ﴿وَما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾ فهو في حقِّ الكفَّار، حيث قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثى * وَما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً * فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَياةَ الدُّنْيا * ذلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدى﴾ (النجم: 27 - 30)، فهو في مقام إبطال تسميتهم الملائكة باسم الأُنثى.
وأمَّا قوله سبحانه: ﴿وَما يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِما يَفْعَلُونَ﴾ فقد جاء ضمن مخاطبته للمشركين بقوله: ﴿قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ * قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ * وَما يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِما يَفْعَلُونَ * وَما كانَ هذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرى مِنْ دُونِ اللهِ وَلكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ * أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ﴾ (يونس: 34 - 38).
وأمَّا قوله (عزَّ من قائل): ﴿وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ فقد كان بصدد الكلام على أعداء الأنبياء (عليهم السلام) وعموم الكافرين، حيث قال: ﴿وَكَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَياطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ ما فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَما يَفْتَرُونَ * وَلِتَصْغى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا ما هُمْ مُقْتَرِفُونَ * أَفَغَيْرَ اللهِ أَبْتَغِي حَكَماً وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتابَ مُفَصَّلاً وَالَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ * وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لَا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ * وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ * إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ (الأنعام: 112 - 117).
فها أنت ترى أنَّ الآيات الكريمة ناظرة إلى اتِّباع الكُفَّار والمشركين للظنِّ والتخرُّص دون العلم واليقين في مسائل عقديَّة، وليست ناظرة إلى الأحكام الفرعيَّة لا من قريب ولا من بعيد.
ومن المعلوم للعدوِّ قبل الصديق أنَّ علماء الإماميَّة مجمعون - تبعاً للكتاب العزيز كهذه الآيات الثلاث، وأحاديث المعصومين (عليهم السلام)، ودليل العقل القطعي - على عدم جواز بناء العقيدة على الظنِّ، بل لا بُدَّ فيها من تحصيل القطع واليقين.
وأمَّا قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً﴾ (الإسراء: 36)، فهو أفضل ما يمكن أنْ يستدلُّوا به على عدم جواز متابعة الظنِّ بشكل عامٍّ حتَّى في الأحكام الشرعيَّة، لأنَّ لفظ (ما) عامٌّ يشمل كلَّ شيءٍ يمكن أنْ يتعلَّق به العلم، وحيث إنَّ الظَّنَّ ليس علماً فلا تجوز متابعته.
ولكن يُجاب عليه من وجوه:
1 - أنَّ المفسِّرين اختلفوا في تفسير هذه الآية بما يُخرجها عن صلاحيَّة الاستدلال بها على حرمة متابعة الظَّنِّ في الأحكام الفرعيَّة، حيث فسَّر بعضهم قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ﴾ بمعنى: لا تقلْ، أي إنها ناهية عن الكذب في القول، وذلك في مجالات ثلاثة:
أحدها: أنْ يكذب في ادِّعاء السَّماع، بأنْ يقول: (سمعتُ كذا) وهو لم يسمعه.
ثانيها: أنْ يكذب في ادِّعاء الرؤية، بأنْ يقول: (رأيتُ كذا) وهو لم يَرَه.
ثالثها: أنْ يكذب في ادِّعاء العلم، بأنْ يقول: (علمتُ كذا) وهو لم يعلمه.
وجعلوا القرينة على هذا التفسير قوله تعالى بعد ذلك: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً﴾.
وبناءً على هذا التفسير تكون الآية أجنبيَّةً عن المقام، ولا يجوز الاستدلال بها على حرمة اتِّباع الظَّنِّ في الأحكام الفرعيَّة.
2 - لو لم نقطع بأنَّ هذا التفسير هو المقصود من الآية فلا أقلَّ من كونه معنىً محتملاً بدرجة وجيهة، فتعود الآية مجملةً من هذه الناحية، ولا يجوز الاستدلال بالمجمل كما هو واضح، لأنَّه استدلال بالأمر المشكوك لا المعلوم، والآية نفسها تنهى عن اتِّباع غير العلم.
3 - لو قطعنا ببطلان هذا التفسير استناداً إلى ما جاء في بعض رواياتنا التي يُفهَم منها أنَّ فقرة: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً﴾ منفصلة عن فقرة ﴿وَلَا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾(51)، فلا تصلح تلك الفقرة كقرينة على ذلك التفسير، وتبقى هذه الفقرة صالحة للاستدلال بها على حرمة اتِّباع غير العلم في جميع المجالات حتَّى الأحكام الشرعيَّة.
ولكن مع ذلك لا يجوز لمنكري التقليد الاستدلال بها على حرمة متابعة الظَّنِّ في الأحكام الفرعيَّة، لأنَّ دلالتها على ذلك هي دلالة ظنِّيَّة، وبالتالي فإنَّ استدلالهم بالآية يتوقَّف على حصول قطعين:
الأوَّل: القطع بأنَّ المقصود من النهي الوارد فيها هو الحرمة، فلو كان المقصود منه هو الكراهة أو كان النهي مجملاً فلا يصحُّ لهم الاستدلال بها.
الثاني: القطع بأنَّ الحرمة شاملة للأحكام الشرعيَّة أيضاً، ولا تختصَّ بالمسائل العقديَّة.
ولا يمكن حصول القطع بأيِّ واحدٍ من هذين الأمرين.
أمَّا عدم القطع بأنَّ المقصود هو الحرمة فلأنَّ غاية ما يُدَّعى هو أنَّ النهي ظاهر في التحريم، والظهور لا يفيد القطع، بل أقصى ما يفيده هو الظنُّ.
وذلك لأنَّ النهي في النصوص يُستَعمل تارةً في الحرمة، وتارةً في الكراهة، فإذا قامت قرينة على الترخيص في الفعل المنهيِّ عنه كان النهي بقرينة الترخيص ظاهراً في الكراهة، وإنْ لم تقم قرينة على الترخيص كان ظاهراً في الحرمة، والظهور هنا لا يفيد أزيد من الظَّنِّ.
وإذا لم تكن دلالة الآية على التحريم قطعيَّةً بل ظنّيَّة لم يجز لمنكري التقليد الاستدلال بها على مدَّعاهم، لأنَّه استدلال بما هو ظنِّيٌّ على حرمة الظَّنِّ.
وأمَّا عدم القطع بالثاني فلأنَّ المستند في شمول الآية للأحكام الشرعيَّة هو أنَّ لفظ (ما) الوارد في فقرة ﴿ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ ظاهر في العموم والشمول، وقد تقدَّم أنَّ أقصى ما يفيده الظهور هو الظَّنُّ، لا القطع.
والنتيجة: لا يجوز لمن يُحرِّم الاستدلال بالأدلَّة الظنّيَّة أنْ يستدلَّ بهذه الآية على بطلان الاستدلال بالظنِّ، لأنَّها دليل ظنّيٌّ أيضاً.
هذه جملة من النصوص التي استدلَّ أو يمكن أنْ يستدلَّ بها المنكرون للتقليد لحرمة العمل بالظَّنِّ في الأحكام الشرعيَّة، وقد عرفت ضعفها جميعاً وعدم صمودها أمام النقد العلمي.
الهوامش:
(1) بحث مستل من كتاب (مرجعية الفقهاء في زمن الغيبة) للكاتب والذي هو تحت الطبع.
(2) وسائل الشيعة (ج 27/ ص 40/ أبواب صفات القاضي/ الباب 6/ ح 6).
(3) وسائل الشيعة (ج 17/ ص 89/ أبواب ما يُكتَسب به/ الباب 4/ ح 4).
(4) وسائل الشيعة (ج 3/ ص 467/ أبواب النجاسات/ الباب 37/ ح 4).
(5) وسائل الشيعة (ج 27/ ص 41/ أبواب صفات القاضي/ الباب 6/ ح 12).
(6) وسائل الشيعة (ج 27/ ص 61/ أبواب صفات القاضي/ الباب 6/ ح 51).
(7) وسائل الشيعة (ج 27/ ص 62/ أبواب صفات القاضي/ الباب 6/ ح 52).
(8) وسائل الشيعة (ج 27/ ص 52/ أبواب صفات القاضي/ الباب 6/ ح 38).
(9) وسائل الشيعة (ج 27/ ص 52).
(10) وسائل الشيعة (ج 27/ ص 56).
(11) وسائل الشيعة (ج 27/ ص 58).
(12) وسائل الشيعة (ج 4/ ص 306/ أبواب القبلة/ الباب 5/ ح 1).
(13) وسائل الشيعة (ج 4/ ص 308/ أبواب القبلة/ الباب 5/ ح 2).
(14) المصدر السابق (ح 6).
(15) الفتوحات المكّيَّة (ج 6/ ص 40/ الباب 366/طبعة 1/ 1424هـ/ دار صادر).
(16) المصدر السابق (ص 49).
(17) إلزام الناصب (ج 2/ ص 235).
(18) مرآة العقول (ج 1/ ص 619).
(19) إلزام الناصب (ج 2/ ص 178)، النسخة الأُولى تبدأ من (ص 179) إلى (ص 213)، والثانية من (ص 213) إلى (ص 232)، والثالثة نقلها عن كتاب (الدُّرُّ المُنَظَّم في السِّرِّ الأعظم) لمحمّد ابن طلحة أحد علماء الشافعيَّة، وتبدأ من (ص 232) إلى (ص 241).
(20) وسائل الشيعة (ج 27/ ص 43/ أبواب صفات القاضي/ الباب 6/ ح 18).
(21) وسائل الشيعة (ج 25/ ص 428/ كتاب إحياء الموات/ الباب 12/ ح 3).
(22) الكافي (ج 1/ ص 69/ باب الأخذ بالسُّنَّة وشواهد الكتاب/ ح 5).
(23) المصدر السابق (الحديثان 3 و4).
(24) المصدر السابق (الحديثان 1 و2).
(25) بحار الأنوار (ج 2/ ص 224).
(26) أمّا كلام السيد الخوئي والحر العاملي فقد ذكرهما الكاتب في كتابه تحت الطبع بعنوان (مرجعية الفقهاء في زمن الغيبة).
(27) تصحيح اعتقادات الإماميَّة (ص 72 و73).
(28) المصدر السابق.
(29) الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد (ص 10 و11).
(30) العُدَّة في أُصول الفقه (ص 729 و730).
(31) معارج الأُصول (ص 278).
(32) المصدر السابق (ص 277).
(33) المصدر السابق (ص 278).
(34) المصدر السابق (ص 275).
(35) وسائل الشيعة (ج 27/ ص 129/ أبواب صفات القاضي/ الباب 10/ ح 15).
(36) وسائل الشيعة (ج 27/ ص 124/ أبواب صفات القاضي/ الباب 10).
(37) الكافي (ج 1/ ص 53/ باب التقليد/ ح 1 و3) كلُّ حديث بطريق.
(38) عبارة: (إلى أنْ قال) في الموضعين من صاحب الوسائل اختصاراً للرِّواية، وليست منّا.
(39) وسائل الشيعة (ج 27/ ص 131/ أبواب صفات القاضي/ الباب 10/ ح 20).
(40) وسائل الشيعة (ج 27/ ص 32/ أبواب صفات القاضي/ الباب 5/ ح 5).
(41) المصدر السابق (ح 6).
(42) الكافي (ج 7/ ص 407/ باب أصناف القضاة/ ح 2).
(43) الكافي (ج 7/ ص 407/ باب من حكم بغير ما أنزل الله/ ح 1).
(44) الكافي (ج 7/ ص 408/ باب من حكم بغير ما أنزل الله/ ح 2).
(45) المصدر السابق (ح 3).
(46) الفتوحات المكّيَّة (ج 6/ ص 40/ الباب 366).
(47) وسائل الشيعة (ج 27/ ص 40/ أبواب صفات القاضي/ الباب 6/ ح 8).
(48) الكافي (ج 2/ ص 400/ باب الشَّكُّ/ ح 8).
(49) بحار الأنوار (ج 74/ ص 153/ ح 123).
(50) وسائل الشيعة (ج 17/ ص 87/ أبواب ما يُكتَسب به/ الباب 4/ ح 1).
(51) وهو ما رواه أحد أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: كنت أُطيل القعود في المخرج - يعني بيت الخلاء - لأسمع غناء بعض الجيران، قال: فدخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال لي: «يا حسن، ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً﴾، السَّمْعُ ومَا وَعَى، والبَصَرُ ومَا رَأَى، والفُؤادُ وما عُقِدَ عَلَيهِ» (وسائل الشيعة: ج 17/ ص 311/ أبواب ما يُكتَسب به/ الباب 99/ ح 29).