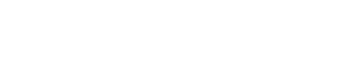(٨٢٦) الانتظار، الترقب، التربص، التحسّس
(٨٢٦) الانتظار، الترقب، التربص، التحسّس
الانتظار، الترقب، التربص، التحسّس
الشيخ إبراهيم الأنصاري البحراني
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى: ﴿بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ﴾
سأعرض في مقالتي هذه إضاءات في عقيدة الانتظار وكيفية التحلّي به وتطبيقه في الحياة الفردية والإجتماعية، وستكون للكلمة خمسة محاور رئيسة تدور حولها الإضاءات كما أنّ لكلّ محور عددا من المقامات التفصيلية:
المحور الأوّل: مدخل قرآني في علّة الانتظار:
المقام الأوّل: الخلافة الإلهيّة في القرآن:
قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً﴾. الظاهر من الآية المباركة حيث أطلقت فيها كلمة (الجعل) دون (الخلق) أنّه ليس المراد أنّ آدم نفسَه هو خليفة الله في الأرض بل كان خلق آدم لأجل تلك الخلافة التّي سوف يمنحها ويجعلها سبحانه لبعضٍ من وُلده وهم الخُلَّص من عباده وهم الذين يجدر أن يطلق عليهم الإنسانُ الكامل بمعنى الكلمة وهم الذين ورد في شأنهم (خلقكم الله أنواراً فجعلكم بعرشه مُحدقين حتَّى منَّ علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويُذكر فيها اسمه).
وبالطبع هم نور واحد وحقيقة فاردة وإن تكثّروا في عالم الطبيعة ومن هنا نشاهد أنّه سبحانه لم يذكر الخليفة بصورة الجمع فلم يقل خلائف أو خلفاء بل جعلها مفردة وهذه الخلافة هي الأمانة الإلهيَّة بعينها وتعني النيابة عنه تعالى في جميع شئونه وصفاته الجمالية والجلالية وهو أمر عظيم قد ذكره سبحانه في قوله: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً﴾.
والسر في تحمله تلك الأمانة يكمن في أنّه مظهر لأسماء الله الجلالية والجلال معاً بخلاف سائر الموجودات حيث أنّها إمّا هي تجليات الجمال كالملائكة أو تجليات الجلال كالجنّ وبعض الحيوانات ولذلك قال سبحانه مخاطباً لإبليس: ﴿يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَاسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنْ الْعَالِينَ﴾.
قال الإمام الخميني (قدِّس سرُّه): فهو تعالى بحسب مقام الإلهية مستجمع للصفات المتقابلة كالرحمة والغضب، والبطون والظهور، والأوّليَّة والآخريّة، والسخط والرضا، وخليفته لقربه إليه ودنّوه بعالم الوحدة والبساطة مخلوق بيدي اللطف والقهر وهو مستجمع للصفات المتقابلة كحضرة المستخلف عنه. ولهذا اعترض على إبليس بقوله تعالى: ﴿ما مَنَعَكَ أنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيّ﴾. مع أنّك مخلوق بيد واحدة. فكل صفة متعلقةٌ باللطف فهي صفة الجمال، وكل ما يتعلق بالقهر فهو من صفة الجلال. فظهور العالم ونورانيّته وبهائه من الجمال وانقهاره تحت سطوع نوره وسلطة كبريائه من الجلال وظهور الجلال بالجمال واختفاء الجمال بالجلال. جمالك في كل الحقايق ساير وليس له إلاّ جلالك ساتر.
وعندما اعترضت أو بالأحرى سألت الملائكة ربّها ﴿...أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾ أجابهم سبحانه و﴿قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾، فلم يُنكر سبحانه تلك الأمور أعني الإفساد في الأرض وسفك الدماء كظاهرة سوف تصدر من هذا البشر بل الظاهر أنَّه قد قرَّرها، ولكنه سبحانه بيَّن للملائكة أنَّهم جاهلون بحقيقة الأمر.
ومن هنا ظهرت مقولة مقدّسة قد تحلّت بها الملائكة ألا وهي (الانتظار) وأعني به انتظار أمر البشر، فهل سيرتقي إلى قمّة الكمال والعروج والهداية أو كما ظنّت الملائكة سيفسد في الأرض ويسفك الدماء؟
المقام الثاني: الانتظار لغةً واصطلاحاً:
قال صاحب المفردات في مادة نظر: النظر تقليب البصر والبصيرة لإدراك الشيء ورؤيته، وقد يراد به التأمل والفحص، وقد يراد به المعرفة الحاصلة بعد الفحص... والنظر الانتظار يقال نظرته وانتظرته وأنظرته.
وأيضاً قال: في مادة (صبر) ويعبّر عن الانتظار بالصبر لما كان حق الانتظار أن لا ينفك عن الصبر بل هو نوع من الصبر، قال: (فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ) أي انتظر حكمه لك على الكافرين.
أقول: (إنَّ هذا الاستعمال هو استعمال مجازي من باب استعمال اللازم وإرادة الملزوم وهو شائع في كلام العرب. هذا وللانتظار معنىً في الاصطلاح ويعنى به خصوص انتظار (فرج الله) الذي هو فرج حجة الله الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر (روحي وأرواح العالمين له الفداء) الذي به يكشف الله الغم وينفِّس الهم، ومن هذا المنطلق تُبِعت الكلمة بكلمة الفَرَج الذي هو الانكشاف، وهذا المعنى للكلمة هو المقصود منه في أحاديثنا الشريفة.
المقام الثالث: شواهد قرآنية دالة على الانتظار:
هناك آيات كثيرة تؤكّد على ضرورة الانتظار وأعنى به (انتظار الأمر) أمر الفرج والمخرج والهداية والكمال، حيث أنّه من أعظم المقدّسات الإلهية وهو ذروة العشق ففي كتاب إكمال الدين باسناده عن يَحْيَى بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ الصَّادِقَ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ (عَزَّ وجَلَّ) ﴿الم ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ فَقَالَ: الْمُتَّقُونَ شِيعَةُ عَلِيٍّ (عليه السلام)، وأَمَّا الْغَيْبُ فَهُوَ الْحُجَّةُ الْغَائِبُ، وشَاهِدُ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَيَقُولُونَ لَوْلاَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنْ الْمُنْتَظِرِينَ﴾.
وعند التأمّل في سيرة الأنبياء والأولياء نشاهد أنّ من أهم أمنياتهم وأشدّ آمالهم هو مجيء المهدي (عجّل الله فرجه) الذي به يملأ الله الأرض قسطاً وعدلا، وكانوا دائماً بصدد هداية الناس إلى أمره الذي هو أمر الله بعينه كما قال تعالى في توصيفهم ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا...﴾ ومن هذا المنطلق نشاهد أنّ الأنبياء كانوا دائماً يذكرون ذلك الأمر ويشتاقون إليه كما صرّح بذلك القرآن الكريم في مواطن عديدة عن لسان كثير منهم كما ورد عن لسان لوط (عليه السلام): قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إلى رُكْنٍ شَدِيدٍ.
في كتاب كمال الدين وتمام النعمة بإسناده إلى أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما كان قول لوط: ﴿قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إلى رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾، إلا تمنياً لقوة القائم (عليه السلام)، ولا ذكر (ركن) إلا شدة أصحابه، لان الرجل منهم يعطي قوة أربعين رجلاً وان قلبه لأشد من زبر الحديد، ولو مروا بجبال الحديد لقطعوها لا يكفون سيوفهم حتى يرضى الله (عزَّ وجل).
وأيضاً ما ورد عن لسان شعيب ﴿بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ﴾ ففي أصول الكافي.. بإسناده عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله رجل عن القائم يسلّم عليه بأمرة المؤمنين؟ قال: لا ذاك اسم سمى الله به أمير المؤمنين (عليه السلام)، لم يسمّ به أحد قبله ولا يتسمّى به بعده إلا كافر، قلت: جعلت فداك كيف يسلِّم؟ قال: يقولون السلام عليك يا بقية الله، ثم قرأ: ﴿بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾
المحور الثاني: انتظار الفرج:
المقام الأوّل: أهمّية انتظار الفرج:
عندما نتمعَّن في الأحاديث المختلفة الصادرة عن المعصومين (عليهم السلام) نستنتج أنَّ الأعمال كلَّها مع ما فيها من الأهميَّة والاعتبار فهي قليلة الشأن في قبال الانتظار فهو: (أفضل الأعمال) فجميع الأعمال العبادية مع ما لها من القدسيَّة والروحانيَّة دون مستوى الانتظار فهو: (أفضل عبادة الأمَّة) والجدير بالذكر أنَّ هذه العبادة أعني الانتظار قد دخلت في ساحة أهمّ العبادات وهو الجهاد في سبيل الله وصار (أفضل جهاد الأمة) كما في الحديث التالي الصادر عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلَّم) حيث قال: أفضل جهاد أمتي انتظار الفرج.
ومن زاوية عرفانيَّة فللانتظار أيضاً مستوى رفيع من العرفان والروحانيَّة حيث صار (أحبَ الأعمال إلى الله) حتَّى وصل المنتظر إلى مستوى الشهيد في سبيل الله.
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): انتظروا الفرج ولا تيأسوا من روح الله، فإن أحبَّ الأعمال إلى الله (عزَّ وجل) انتظار الفرج... والمنتظرُ لأمرنا كالمتشحِّطِ بدمه في سبيل الله.
فما هو الأمر المتوقع من المجاهد في سبيل الله حين الجهاد؟ وما قيمة المجاهد لولا النيّةُ الصادقة المنطلقة من رضا الله؟ هذا الأمر بنفسه في أعلى مستواه متوفِّرٌ في المنتظر الحقيقي الذي يتمنَّى في كلِّ صباحٍ ومساءٍ أن يعيش في ظلِّ ذلك المعشوق روحي لتراب مقدمه الفداء ولسان حاله: (فأخرجني من قبري مؤتزراً كفني شاهراً سيفي مجرداً قناتي ملبياً دعوةَ الداعي في الحاضرِ والبادي) وهو بقربه إلى الله وشهوده مقامَ ربِّه صار كالشهيد متشحِّطاً بدمه في سبيل الله، وليس للشهيد خصوصيةٌ في الخارج بل الخصوصية والقيمة لمفهوم الشهادة التي تعني الوصول إلى الله وشهود وجه المحبوب، والمنتظِر يؤدِّي نفس الدور حيث يشاهد وجهَ ربه وهو في نفس الوقت يعيش مع الناس. والحديث التالي قد بيَّن السر الذي رفع مستوى الانتظار إلى هذه الدرجة:
عن أبي حمزة الثمالي عن أبي خالد الكابلي عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال: تمتدُّ الغيبة بولي الله الثاني عشر من أوصياء رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلَّم) والأئمة (عليهم السلام) بعده، يا أبا خالد إنَّ أهل زمان غيبته والقائلين بإمامته المنتظرين لظهوره أفضل أهل كل زمان لأن الله تعالى ذكرُه أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبةُ عندهم بمنزلةِ المشاهدة وجَعلهم في ذلك الزمان بمنزله المجاهدين بين يدي رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلَّم) بالسيف، أولئك المخلصون حقاً وشيعتُنا صدقاً والدعاةُ إلى دين الله سراً وجهراً.
وهناك أحاديث تؤكِّد على أنَّ (انتظار الفرج من الفرج) بل (انتظار الفرج من أعظم الفرج). (... عن محمد بن الفضيل عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن شيءٍ من الفرج. فقال: أليس انتظار الفرج من الفرج؟ إنَّ الله (عزَّ وجلَّ) يقول: ﴿فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ﴾ وهذا المعنى من الانتظار قد اكتسب قسطاً من القدسية والاعتبار بحيث صار من علائم الإخلاص الحقيقي والتشيُّع الصادق ومن مميزات الدعاة إلى دين الله سراً وجهراً وقد ورد في الحديث: (...أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله سراً وجهراً.. )
المقام الثاني: السرّ في أهميّة الانتظار:
إن التقييم في المنطق الإلهي يختلف تماماً عن التقييم في المنطق المادِّي ومن الخطأ جداً محاولة تقييم القضايا المعنوية الراقية والمفاهيم الروحانية السامية بالمعايير الماديَّة، حيث أن هناك بوناً بعيداً بينهما بل هما في طرفي النقيض، وقد وصل التضادّ بينهما إلى مستوى بحيث لا يمكن أن ينقطع الإنسان إلى المعنويات إلا بالابتعاد الكامل عن المادِّيات، ولا أعنى من الابتعاد عن المادة هو تركها من رأس بل أعني الزهد فيها وعدم انشغال الذهن بها.
فبما أنّ الله سبحانه هو القدّوس فمن المستحيل أن يتحلّى أمر ما بالقدسيّة إلاّ بارتباطه بالله تقدّس وتعالى، وقدسيةُ الشيء تزيد وتنقص حسب ظهور اسم الله فيه، فلنترك إذاً المجال المادي ولنبحث عن الأفضلية في الساحة الإلهية المعنوية.
وحينما نتحدّث عن انتظار فرجِ الله فلابدّ أن نبحث عن الاسم الذي يندرج فيه الفرج؟ إنّ الفرج في الحقيقة يندرج تحت اسم (الكاشف) ففي الدعاء: (يا صريخ المكروبين ويا مجيب المضطرين ويا كاشف الكرب العظيم) (يا كاشف الغم) (يا كاشف الكرب العظام) فماذا بعد الفرج إلا كشف الكربة عن وجه المؤمن برؤية الواقع والأمر، حينما تتحقق تلك الدولة العظيمة التي يعزّ بها الله الإسلام واهله ويذل النفاق وأهله.
فالانتظار إذاً له نتيجتان:
1- إنَّه بالفعل يُحقِّق (كشف الكربة) بنحو مجمل.
2- إنَّه عاملٌ جذري أساسي للفرج بظهوره (عجّل الله فرجه) حيث يسود الحكمُ الإلهي الأرضَ كلّها.
المحور الثالث: الهدف من الانتظار:
المقام الأوّل: التقرّب إلى الله:
لا يخفى على كلِّ من آمن بالله سبحانه أنه ليس في القاموس الإلهي إلاّ ميزان واحد يقاس به الأفضلية وهو الميزان الحقيقي ألا وهو الحق، وغيرُ الحق لا تعدُّ موازين بل يُترائى أنها موازين فلا حقيقة لها ولا ثِقل فيها، قال تعالى: ﴿وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ﴾ . ﴿فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ﴾
والوصول إلى الحق يعني (التقرب إلى الله سبحانه وتعالى)، فينبغي أن يكون هدف المنتظر هو الوصول إلى القرب الإلهي ورضاه (جلّ وعلا)، وبذلك يمكننا تقييم أعمالنا، فوِزانُ الانتظار وزانُ النية التي هي خير من العمل حيث جاء في الحديث: (نية المؤمن خير من عمله) لأن هذه النية من ناحيةٍ هي التِّي ترفع مستوى الإنسان ومن ناحية أخرى تلازم العمل بل توجده قال تعالى: ﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلاً﴾
فالرؤية المهدوية هي التي تصحح سائر الأعمال من العبادات وغيرها، وقد ورد في دعاء الندبة (وَاجْعَلْ صَلَاتَنَا بِهِ مَقْبُولَةً وذُنُوبَنَا بِهِ مَغْفُورَةً ودُعَاءَنَا بِهِ مُسْتَجَاباً واجْعَلْ أَرْزَاقَنَا بِهِ مَبْسُوطَةً وهُمُومَنَا بِهِ مَكْفِيَّةً وحَوَائِجَنَا بِهِ مَقْضِيَّةً).
المقام الثاني: تنمية روحية الرجاء بالله تعالى:
إنَّ من أهم نتائج انتظار الفرج تنميةَ روحيةِ الرجاء بالله في الإنسان المؤمن، حيث يُشاهد أمامَه مجالاً وسيعاً من الفضل والكرم والخير الإلهي الذي سوف تظهر مصداقيَّتُها في تلك الدولة العظيمة المباركة، وهي دولة المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه، تلك الدولة الكريمة التِّي يعزُّ الله بها الإسلام وأهلَه ويذلُّ بها النفاق وأهلَه، ومن الطبيعي أن من يحوز على تلك الرؤية النورانيَّة أن يترفَّع عن الدنيا وزخرفها ومغرياتها وتسويلاتها الشيطانية، وهذا الأمر (أعني تحقير المظاهر الدنيويَّة) هو أوَّل خطوة يخطوها السالك إلى الله وهي (التخلية) التِّي تستتبعها (التحلية)، ومثل هذا الإنسان المؤمن قد وصل بالفعل إلى مُستوى من العرفان والعبودية بحيث يكون لسان مقالِه وحالِه وعملِه هو: (صلِّ على محمدٍ وآل محمد وأثبتْ رجائك في قلبي واقطعْ رجائي عمَّن سواك حتى لا أرجو إلا إيّاك) ثمَّ يترقَّى في العبوديَّة فيقول: (بسم الله الذي لا أرجو إلاّ فَضله) (يا من ارجوه لكل خير).
هذه الروحية إن تركَّزت في الإنسان المؤمن فسوف تُعمِّق جذورَها فتزيل جميعَ الأشواك والموانع الصادَّة، لتنشرَ فروعَها الطيِّبة وثمارَها الجنيَّة في السماء حتَّى تؤتى أكلَها كلَّ حينٍ بإذنِ ربِّها.
ونظراً إلى الحديث المتواتر (إنَّ أمرَنا صعبٌ مستصعبٌ لا يَحتمله إلا مَلَكٌ مقرَّب أو نبيٌّ مُرسلٌ أو عبدٌ امتَحَن اللهُ قلبَه للإيمان) نعرف أن الواقع الذي سوف يحققه ولي الأمر (عجّل الله فرجه) هو واقع يختلف تماماً عمّا نعيشه نحن في عصرنا الحالي من العيشة المادية الصرفة التي لا تتحلى بالمعنوية والنورانية أصلاً، وقد مَلئَت هذه الدنيا أفكارَنا وأذهاننا بحيث لم تسمح لنا أن نتصور تلك الدولة تصوراً صحيحاً ناهيك عن التصديق بها كما هي، وبالفعل صار هذا الأمر أمراً صعباً مستصعباً علينا.
وعليه: يتأكد علينا أن نجدد النظر في فهم ومعرفة تلك الدولة المباركة كي نرغب فيها فنطلبها فننتظرها وفي زيارة الجامعة الكبيرة: (عارفٌ بحقكم مقر بفضلكم محتمل لعلمكم محتجبٌ بذمتكم، معترفٌ بكم مؤمنٌ بإيابكم، مصدِّقٌ برجعتكم، منتظرٌ لأمركم، مرتقبٌ لدولتكم)
المحور الرابع: قوام الانتظار من الناحية الباطنية والظاهرية:
المقام الأوّل: جانب اليأس وجانب الرغبة في المنتظر:
إنَّ كلمة الانتظار تدُّل على حالتين كامنتين في روح المنتظر، لكل منهما دور مهمّ في معنى الكلمة وهذان الجانبان هما:
1- الجانب المطلوب والمحبوب للمنتظِر والمتوقَّع الوصول إليه، وهو الخير والبركة وتمكين الدين على الأرض كلِّه، فلو لم يتوقع حدوث حالة جديدة وإيجابية في المستقبل فلا مصداقية للانتظار ولا معنى له.
2- الجانب غير المطلوب وغير المحبوب الذي يتمثَّل في الحالة الفعلية التي يعيشها المنتظر، تلك الحالة المؤلمة التي يرجو المنتظر الخلاص منها، فلو كان الوضع الفعلي هو الوضع المطلوب فلا معنى للانتظار إذن ولا مبرر له أصلا.
وبعبارة أوضح: هناك تناسب عكسي بين أمرين هما:
1- اليأس من الحالة الفعليَّة المعاشَة.
2- الرغبة في الحالة المستقبليَّة المتوقعة.
هذا ما يستفاد من نفس كلمة الانتظار من دون النظر إلى أي أمرٍ آخر خارج عنها وتشهد لهذه الحقيقة الآية الكريمة التِّي وردت في هذا المجال حيث السياق وحيث الأحاديث الدالَّة على ذلك. قال تعالى: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ﴾ (النمل/62).
الآية الكريمة تشير إلى الجانبين المتواجدين في نفس المضطر:
1- سوءٌ غير مكشوف وهو السوء المطلق الذي من خلاله نشأت سائر ألوان السوء، وهذا السوء يتمثَّل في أمرٍ واحد وهو أنَّ الخلافة الظاهرية للأرض ليست بيد المُضطَر.
2- هناك توقُّع ورجاء ورغبة كامنة في نفس المضطر وهي أن تكون الخلافة العامَّة على جميع الأرض له ولمن يقتدي به ويخطو خطاه.
وأمّا الحديث عن شخصيَّة المضطر وأنَّه من هو؟ فهو خارج عن بحثنا ههنا ولكن قوله تعالى ﴿وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْضِ﴾ يُنبأنا عن حقائق أخرى تعرف بالتأمّل.
فلا يمكن للمؤمن ممارسةُ عمليةِ الانتظار إلاّ بعد معرفة أمرين متلازمين:
الأول: وهو الأصل والأهم، ويتمثَّل في (معرفة تلك الخلافة الإلهيَّة) وهذا هو التولِّي الذي يُعدُّ من فروع الدين.
الثاني: وهو تابعٌ وملازم للأصل، وهو (معرفة السوء) الذي يتمثَّل في الواقع الفعلي ومن ثمَّ التبرِّي منه الذي هو أيضاً من فروع الدين.
وهنا قد حان الحديث عن مقولة (الرفض) الذي هو من أركان الانتظار فنقول:
المقام الثاني: الانتظار والرفض الإجتماعي:
إنَّه من الضروري لمن يعيش حالة الانتظار أن يعرف مدى انحراف الواقع الفعلي عن الحقيقة والصواب، وينبغي أن يصل إلى مستوى من الانزجار والتنفُّر بحيث يحسّ بأنَّه بالفعل سجين في هذه الدنيا مقيّدٌ بأنواع القيود التِّي لا مفكَّ ولا خلاص منها إلاّ بظهور المنجي الحقيقي وهو (الحجة بن الحسن المهدي (عجّل الله فرجه)).
وينبغي له أن يشعر بأنَّ المشكلة التِّي يعيشها ليست هي مُشكلةٌ جزئيَّة يمكن التخلُّص منها بسهولة بل هي مُشكلةٌ كبيرة ومعضلةٌ عظمى قد رسَّخت جذورَها في جميع الأرجاء ونشرت سمومَها في كافة الأنحاء، فعندما نلاحظ المجتمع نري بشاعة الظلم وانتشار الجور وضياع الحقوق والحرِّيات واختلاط الحق بالباطل.
فمثلاً نشاهد أنَّ أجهزة الإعلام العالميَّة تجسِّد الباطل كأنَّه الحقّ وتصوِّر الكذب كأنه الصدق، وكلُّ شيءٍ حول الإنسان مزيَّف ولكنَّه لا يشعر بهذه المشكلة التي تحيط به، بل يتوهَّم الحريَّة الزائفة، فلا يفكر إذن في تبديل ما هو عليه من الانحراف والإغفال. فإذاً للتعجيل في فرجه (عجّل الله فرجه) ولإيجاد الداعي في المجتمع يجب أن يعُمُّ، وعلى الأقلّ الشعور بالمظلوميَّة كي يعلم الإنسان ويحس بكلِّ وجوده بأن الظلم قد شمله هو أيضاً وأنَّه يعيش تحت ظلّ تلك الشجرة الخبيثة التّي غرسها من أسَّس أساس الظلم والجور على أهل البيت (عليهم السلام) حيث ظهر الفساد في البرِّ والبحر، وبعد انتشار هذا المنطق لا محالة سوف يفكر المنتظِر في إنقاذ نفسه وأهله ومجتمعه من هذه المشكلة.
وللخلاص من هذه المعظلة من رأس ينبغي لنا أن نعرفَ أنَّه لا محيص ولا مناص إلاّ بتوجُّهه (عجّل الله فرجه)، ومن ثمَّ ظهوره ومباشرته للحلّ بأسلوبٍ ملكوتي إلهي.
وعلينا أن نُدرك هذه الحقيقة بجميع وجودنا، وأن ندافع عنها بأرواحنا ودمائنا وأجسادنا وجوارحنا، بحيث لا تمرُّ علينا ساعة بل لحظة واحدة إلا ونشعر بفقدان النور وهيمنة الظلام، وهذه الحالة لا تحصل إلا بالمعرفة، أعنى معرفة الله ومعرفتهم (عليهم السلام) ودولتهم المباركة، فلا بد أن نكون على بصيرة من أمرنا حيث أن الأعمى لا يمكنه أن يدرك النور مهما شُرِح له.
وهذه المعرفة تلازمها معرفة أخرى وهي معرفة أساليب الأعداء الشيطانيَّة ومستوى عداوتهم للحق وانحرافهم عن الواقع وبُعدهم عن الله تعالى.
فعند وصول المؤمن إلى هذه المرحلة من الوعي والإدراك ينبغي له أن يلتزم بواجب هو من أهمِّ الواجبات ألا وهو التبري من أعداء الله.
ثمَّ إنَّ هذه الحالة النفسية أعني الرفض سوف تكون لها آثار إيجابيَّة في أخلاقه وأعماله تجعله يشتاق إلى ما سيحقَّق من النصر وتمكين الحق، وهكذا سوف يزداد الاشتياق إلى أن ينقلبَ إلى قرارٍ حاسمٍ ومن ثمَّ إرادة جدِّية وطلب مؤكَّد، وحينئذ سوف يراه المهدي (عجّل الله فرجه): (متى ترانا)
ومثل هذا الإنسان سوف يتفاجأ برؤية الإمام (عجّل الله فرجه) فلا يرى نفسَه إلاّ ويعيش دولته العظيمة وظلِّه الملكوتي المبارك: (ونراك وقد نشرت راية الحق)
الرفض من العبادات الاجتماعيَّة:
من النتائج الخبيثة والآثار السيِّئة التي نشأت جرّاء عزل الدين عن المجتمع وفصلة عن الحُكم خلال قرونٍ متواليةٍ، هو تحريف المفاهيم الدينية وتفسيرها تفسيراً مؤطَّراً بإطار الفرد لا يتخطاه قيد أنملة وكأنَّ الدين لا يمتُّ إلى المجتمع بصلة، وهذه الآفة قد تسرَّبت بشدّة في تقييم المفاهيم الأخلاقية الواردة في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة، فقد فُسِّرت جميعها أو أكثرها تفسيراً فردياً وكأنَّها لا علاقة لها بالمجتمع ولا مساس لها بالأمَّة، وكأن الغاية من بعث الرسل وإنزال الكتب هي إيصال الأفراد فحسب إلى الكمال المطلوب.
ومن المؤسف أنَّ هذا النوع من التفسير مع غاية بعده عن روح الإسلام صار كالبديهي عند أكثر المسلمين حتى عند علمائهم، فترسَّخت جذورها في المجتمع الإسلامي إلى حدٍّ أصبح كلُّ من يخالفها من جملة الشاذِّين عن الدين وفي زمرة المنحرفين عن الصراط المستقيم وبالنتيجة من المطرودين والخارجين عن ربقة الإسلام والمسلمين!
هذا والقرآن بصريح العبارة يبيِّن السرّ في بعث الرسل بقوله: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾
ومن الواضح أنَّ (للحديد) الذي هو كناية عن القدرة دورٌ مهم وأساسي في بناء المجتمع فهو الساعد الآخر الذي يضمن تنفيذَ قوانين الدين بعد (الإيمان بالله). ولم يكتف القرآن بذلك بل حرَّضَ كافة المؤمنين على القيام بالقسط فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾.
وعلى ضوئه ينبغي أن لا ننظر إلى المفاهيم الإسلامية من منظار فردي فحسب، بل لا بد أن يكون المنظار الاجتماعي هو الحاكم وهو المخيم عليها.
فالتقوى مثلاً ليس مفهوماً أخلاقياً فردياً فحسب بل هو مفهوم اجتماعي أيضاً، فهناك تقوى في الإنسان كفرد وهناك تقوى أهمّ وهو التقوى بمفهومه الاجتماعي الذي يرجع إلى الأمَّة المؤمنة، ولكلٍ أثره الخاص به وجزائه المترتب عليه وثوابه المنسجم معه. وكذلك مفهوم الإيثار والإخلاص والكرم والجود والغيرة والشجاعة وغيرها من القيم الإنسانية الإسلامية.
نفس الكلام يتأتّى في المفاهيم المضادَّة والقِيم المنحرفة الشاذَّة كالبخل والرياء والنفاق والخيانة والشره والجبن وغيرها.
نعم هناك بعض المفاهيم، وهي قليلة، يتغلَّبُ عليها الجانب الفردي كما أن هناك مفاهيمَ يتغلب عليها الجانب الاجتماعي، مع ذلك لا يعني هذا أن نتمسك بها كمفاهيم خاصّة فرديَّة.
والمتأمل في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة سوف يذعن بما قلناه ولا بأس بذكر مثال واحد وهو ما ورد في سورة الشعراء في آياتٍ ثمانية عن لسان عددٍ من الأنبياء: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ﴾
وكذلك في سورة الزخرف فهذا الخطاب هو خطابٌ للمجتمع البعيد عن واقع الدين، وليس الخطاب متوجِّهٌ إلى الأفراد خاصَّةً.
ومن هذا المنطلق نقول لو أن القيم الأخلاقية أو المفاهيم الاعتقادية رسخت في عدد من الأفراد حق الرسوخ ولكن لم تتجسد تلك المفاهيم في الأمة الإسلامية كأمَّة فهل يجدي ذلك نفعا للأمة؟ وهل يرتفع الضرر عن الأمة؟ من الواضح أن ذلك لا يجلب منفعة للأمَّة كما أنه سوف لا يدفع شراً عنها بل الآفة حينئذٍ سوف تتسرَّب إلى الأفراد أيضاً مهما حاولوا التخلُّص منها! قال تعالى: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنْ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾
وقال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاَ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾
وذلك حيث لا استثناء في القانون الإلهي، بل لو دققنا النظر وتعمقنا في الأمر لوصلنا إلى حقيقة أخرى قد استترت عن الكثير وهي: أنه من الصعب أن نحكم بصلاح فرد وهو يعيش في أمة فاسدة، ذلك الفرد الذي لم يوصل نفسَه إلى مستوى القيادة والإشراف على أمَّته أو لم يهجرهم هجراً جميلاً كي يسلم من آفاتهم!
وربما نستلهم هذا الأمر من الآيتين السابقتين:
فبالنسبة إلى الآية الأولي نلاحظ أنَّ الذين نجَوا هم الذين (ينهون عن السوء)، وأمّا الذين ظلموا وهُمْ الفسّاق، سواء المظهِر لفسقِه أو الساكت عن الجريمة، فإنَّ الله سوف يأخذهم بعذابٍ بئيس.
وبالنسبة إلى الآية الثانية نشاهد أنَّ غير الظالمين أيضاً قد شملتهم الفتنة وذلك لأنَّ الاستسلام للظلم هو ظلمٌ أيضاً.
الرفض الاجتماعي
وهاهنا وبصريح العبارة نقول:
إنَّ التكليف الرئيس الذي يُمثِّل أهم التكاليف في عصر الغيبة هو ما أشرنا إليه سابقاً وهو (الرفض) ولكن هذا التكليف ليس هو تكليفاً فردياً فحسب بل هو تكليفٌ اجتماعي، فيلزم على المؤمن أن يكون رفضُه رفضاً ينطلق من منطلق شرعي إلهي حتى يتقرب به إلى الله فيكون عبادةً من نمط العبادات الاجتماعية التي تخيِّم على جميع العبادات الفردية.
ولأجل أن يتَّسم الرافض للمجتمع الفاسد بوسامٍ إلهي ينبغي له أن يمارس البناء الفردي، وهو السعي للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالتلبس بلباس التقوى الذي هو خير لباسٍ حتَّى يرتفع مستوى رفضه هذا من السلب المطلق الذِّي هو (لا) إلى سلبٍ يتضمَّن إيجاباً، وعندئذ سوف يكون رفضُه رفضاً مقدَّساً له معنى ومفهوم رسالي عميق، فليس كلُّ (لاءٍ) هي بالفعل لاء المذمومة، بل هذه (اللاء) التي يعتقد بها المنتظر الحقيقي هي أفضل من ألف (نعم)، إن صحَّ القياس بينهما!
فهذا الرفض ليس من السكوت المذموم الذي هو حالةٌ سلبيةٌ جوفاءُ تُعرقل الإنسان والمجتمع، كلاّ! بل هو حالةُ صراخٍ ليس مثلها صراخ (ويكفيك نموذجاً سكوت عليٍّ (عليه السلام) طوال خمسة وعشرين سنة) وهذه الحالة هي الحالة التكاملية التِّي تبني الإنسان وترفع من مستواه إلى الأعلى وتجعله يتكامل شيئاً فشيئاً من دون الوقوف عند حدٍّ، وكذلك تُنمِّي المجتمع وترفع مستواه وتجعله يعيش عيشة عزيزة لا يعتريها ذلٌّ وهوان ولا تحتوشه آفةٌ وخذلان.
المحور الخامس: كيفيات الانتظار، وصفات المنتظرين :
المقام الأوّل: الارتقاب:
قال تعالى عن لسان شعيب: ﴿وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ﴾ وفي اللغة (الرقيب الحافظ وذلك إما لمراعاته رقبةَ المحفوظ وإما لرفعه رقبته قال تعالى: ﴿وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ﴾ وقد وردت أحاديث استعملت فيها هذه الكلمة بمعنى الانتظار منها: ما ورد في نهج البلاغة عن عليٍّ (عليه السلام) قال: (ومن ارتقب الموت سارع في الخيرات) منها: في كتابه (عليه السلام) لمحمَّد بن أبي بكر (إرتَقبْ وقت الصلاة فصلِّها لوقتها ولا تعجلْ بها قبلَه لفراغٍ ولا تُؤخِّرها عنه لشغل..) وقد وردت أحاديث في جري الآية المباركة على مقولة الانتظار ففي تفسير العياشي عن محمد بن الفضيل عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن انتظار الفرج من الفرج؟ قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: ﴿وارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ﴾.
كما أنّ في كتاب كمال الدين وتمام النعمة باسناده إلى أحمد بن محمد بن أبى نصر قال: قال الرضا (عليه السلام): ما أحسن الصبر وانتظار الفرج، أما سمعت قول الله (عزَّ وجل) يقول: ﴿وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ﴾، وقوله (عزَّ وجل): ﴿فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ﴾ فعليكم بالصبر فانه انما يجيء الفرج على اليأس، فقد كان الذي من قبلكم أصبر منكم. وفي زيارة الجامعة الكبيرة نخاطب أئمتنا (عليهم السلام) (مُؤْمِنٌ بِإِيَابِكُمْ مُصَدِّقٌ بِرَجْعَتِكُمْ مُنْتَظِرٌ لِأَمْرِكُمْ مُرْتَقِبٌ لِدَوْلَتِكُمْ).
أقول: من خلال المعنى اللغوي للارتقاب والأحاديث الواردة في هذا المجال نستنتج: أن الانتظار كما يفهم من نفس الكلمة حيث أنها مشتقّة من النظر، إنّما هو رؤية مقدّسة ينبغي أن يمتلكها المؤمن، دون الارتقاب فهو عمل خارجي وحركة ميدانية لابدّ وأن تتحقّق في المجتمع، فوزان الارتقاب بالنسبة إلى الانتظار وزان العمل (كالصلاة) بالنسبة إلى النيّة، فلا صلاة بلا نيّة ولا معنى للنية من غير الصلاة، كذلك لا ارتقاب من دون انتظار ولا معنى للانتظار من دون الارتقاب، فلو كان الارتقاب بمعنى رفعة الرقبة كما ورد في المعنى اللغوي للكلمة، فيعني ذلك المرتقب يكون دائماً رافع الرقبة وهو كناية عن الاستعداد الكامل والتهيئة المستمرّة حيث أن الإنسان الرافع رقبته مستعدّ للعمل غير متخاذل بخلاف الإنسان المطرق رأسه إلى الأسفل، ويدلّ على الفرق الذين ذكرناه ما ورد في الزيارة الجامعة (منتظر لأمركم) فالانتظار له ارتباط بأمر الأئمة (عليهم السلام) (مرتقب لدولتكم) والارتقاب له علاقة بدولتهم الكريمة.
ولو سألت عن المدّة التي ينبغي أن يرتقب المؤمن فيها دولة الحق لقلت: أن قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لاَ أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُباً﴾ يبيّن مدى ذلك فالحقب يعني الدهر والزمان وتنكيره يدل على وصف محذوف والتقدير حقباً طويلاً. قال: في مجمع البيان: أي لا أزال، والحقب الدهر والزمان وجمعه أحقاب قال الزجاج: والحقب ثمانون سنة. وفي المفردات: الصحيح أن الحقبة مدة من الزمان مبهمة.
هذا، وهل لنا الاكتفاء بالارتقاب؟ أقول: كلا بل هناك أمر آخر لابدّ وأن يلازم الارتقاب وهو:
المقام الثاني: التربّص:
التربّص كما ورد في قوله تعالى: ﴿قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنْ اهْتَدَى﴾ وفي الحديث (...عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألت أبي عن قول الله (عز وجل): ﴿فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحابُ الصِّراطِ السَّوِيِّ ومَنِ اهْتَدى﴾ قال: الصراط السوي هو القائم، والمهدي من اهتدى إلى طاعته، ومثلها في كتاب الله (عزَّ وجل): ﴿وإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وآمَنَ وعَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدى﴾ قال: إلى ولايتنا.
وفي تفسير قوله تعالى: ﴿... فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ﴾ ورد الحديث عن الإمام الباقر (عليه السلام): ..التَّرَبُّصُ انْتِظَارُ وُقُوعِ الْبَلاءِ بِأَعْدَائِهِمْ.
المقام الثالث: التحسس:
﴿يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلاَ تَيْئَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لاَ يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الكَافِرُونَ﴾، وهي مرحلة ميدانية حسّاسة تستدعي الدقّة الفائقة في فهم مجريات الأحداث والأمور للوصول إلى زمن المعشوق الإلهي أعني وليّ الله الأعظم أرواحنا لتراب مقدمه الفداء.
ففي قضيّة التمهيد لظهور الإمام الحجّة (عجّل الله فرجه) لابدَّ وأن نعرف أنّ هناك مراحل مختلفة حسب الأزمنة والحالات، وعلى أساس ذلك نشاهد تنوُّع الأحاديث حيث تأمر بعضها بالجلوس والسكوت في مرحلة، والحركة في مرحلة أخرى، كما في حديث (سدير الصيرفي) حيث خاطبه أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قائلاً: يَا سَدِيرُ الْزَمْ بَيْتَكَ وكُنْ حِلْساً مِنْ أَحْلَاسِهِ واسْكُنْ مَا سَكَنَ اللَّيْلُ والنَّهَارُ فَإِذَا بَلَغَكَ أَنَّ السُّفْيَانِيَّ قَدْ خَرَجَ فَارْحَلْ إِلَيْنَا ولَوْ عَلَى رِجْلِكَ.
وكذلك حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله): تَجِيءُ الرَّايَاتُ السُّودُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ كَأَنَّ قُلُوبَهُمْ زُبَرُ الْحَدِيدِ فَمَنْ سَمِعَ بِهِمْ فَلْيَأْتِهِمْ فَبَايَعَهُمْ ولَوْ حَبْواً عَلَى الثَّلْجِ.
وأبلغ حجّة في بيان المرحلتين أعني (مرحلة) السكوت و(مرحلة) التحسس ما نجده في موقف النبي يعقوب (عليه السلام) مع بنيه:
ففي بداية الأمر حيث جاء بنوه وقالوا: ﴿قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ﴾ ففي هذه المرحلة قال: ﴿... بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾ فهذا النمط من الصبر رغم كونه جميلاً ولكن كان متلازماً مع السكوت والسكون حيث لم يجدِ التحرّك والقيام، بخلاف المرحلة الأخرى من الصبر حين قال لهم أكبر أخوتهم ﴿ارْجِعُوا إلى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلاَّ بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حافِظِينَ﴾ ﴿وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾ هنا نشاهد أن التعبير الذي استخدمه النبي يعقوب (عليه السلام) هو نفس التعبير السابق حيث قال: ﴿قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ﴾ ولكن الموقف قد اختلف تماماً حيث قال: ﴿...عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ وهنا قد التجأ يعقوب إلى البكاء ﴿وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ﴾ بحيث قد أوشك إلى الهلاك، ولذلك توجّه إليه بنوه و﴿قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنْ الْهَالِكِينَ﴾ فيا ترى ما هذا النمط من البكاء؟ إنّه بكاء العشق والانجذاب واللقاء الذي ينطلق من العلم بالمستقبل المشرق ويندفع من الاعتقاد بالله سبحانه لذلك ﴿قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إلى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنْ اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾ فكانت نتيجة هذا الصبر والبكاء والالتجاء إلى الله تعالى أمراً مهمّا وهو التحسس حين خاطب الأب بنيه وقال لهم ﴿يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلاَ تَيْئَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لاَ يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الكَافِرُونَ﴾.
فأفضل الأعمال في هذه المرحلة هو التحسس وأعنى به البحث عن الإمام حتى الوصول إلى مرحلة الإحساس به، كما حدث لأخوة يوسف (عليه السلام)، والتحسس لا ينافي الانتظار بل هو عين الانتظار بمستواه الراقي والارتقاب في مرحلته المتكاملة، والتحسس هو الذي يتطلب الثورة والانطلاق والتحرّك حتى مرحلة العثور.
أمّا السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا وفي هذه المرحلة بالخصوص هذا النمط من التكليف أعني التحرّك والتحسس؟
والجواب هو: أنّ في هذه المرحلة تكون الشواهد والعلامات قد بدأت بالظهور، تلك العلامات التي تؤكّد على وجود يوسف في مكان معيّن وهو (مصر) بل في منصب خاص وهو (الحكم)، هذه العلامات هي التي فرضت على الأب أن يدفع الأبناء دفعاً فوريّاً إلى التحسّس والبحث بجدّ وعدم اليأس والتهاون في الأمر وهذه الشواهد هي:
1- إصرار يوسف على مجيء أخيه من أبيه ﴿..قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ﴾ والتجاؤه في ذلك إلى التشويق ﴿..أَلاَ تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ﴾، ثمّ التهديد ﴿فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلاَ كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلاَ تَقْرَبُونِي﴾.
2- إنّه وضع بضاعتهم في رحالهم بحيث أنّهم وبمجرّد أن ﴿... فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ﴾ وأصرّوا على أخذ بنيامين معهم وأصرّوا على ذلك ﴿.. قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ﴾.
3- أنّ يوسف قد أولى الاهتمام الخاص بأخيه من أبيه بنيامين وذلك حينما ﴿دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ﴾
4- وأيضاً موضوع السقاية حيث ﴿جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ﴾.
فبوجود هذه العلامات ماذا ينبغي أن يفعل الأب؟ صار تكليفه أن يقول لهم ﴿.. بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ ثمّ يحرّضهم ويدفعهم إلى التحسس الفوري من ولي الله كما هو المستفاد من أداة العطف (فاء) الدالة على الفورية فيقول: ﴿يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلاَ تَيْئَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لاَ يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الكَافِرُونَ﴾.