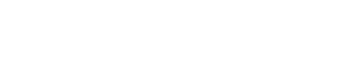سؤال ابن عباس للرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الخلفاء والأوصياء والحجج بعده؟
سؤال ابن عباس للرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الخلفاء والأوصياء والحجج بعده؟
سؤال ابن عباس للرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الخلفاء والأوصياء والحجج بعده؟
ابن مسرور، عن ابن عامر، عن المعلى، عن جعفر بن سليمان، عن عبد الله بن الحكم، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن خلفائي وأوصيائي وحجج الله على الخلق بعدي اثنا عشر أولهم أخي وآخرهم ولدي .
وقيل: يارسول الله ومن أخوك؟
قال صلى الله عليه وآله وسلم: علي بن أبي طالب.
قيل فمن ولدك؟
قال: المهدي يملاها قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما و الذي بعثني بالحق نبيا لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لأطال الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه ولدي المهدي فينزل روح الله عيسى بن مريم عليه السلام فيصلي خلفه وتشرق الأرض بنور ربها ويبلغ سلطانه المشرق والمغرب. (1)
الهوامش:
(1) كمال الدين:1,280.